تجربتي في التّأليف والإبداع
ما هي الدّوافع الّتي دفعتني– وما تزال – للكتابة؟
ما هي العوامل والمصادر الّتي تأثّرتُ بها؟
هل هناك مراحل مررتُ بها؟ وما هي أبرز خصائصها؟
الدّوافع للكتابة:
يمكن إجمال دوافعي للكتابة والغايات المنشودة منها كما يلي:
– الكتابة كواجب ضمن دراستي في المدرسة الثّانويّة وفي الجامعة.
– الكتابة المنهجيّة الموضوعيّة ضمن عملي في مجال التّربية والتّعليم وفي إعداد المناهج التّعليميّة في موضوع اللّغة العربيّة والأدبين العربيّ والعالميّ.
– الكتابة لإشباع حاجات نفسيّة متعدّدة ترتبط بالأوضاع الّتي مررتُ بها؛ فالكتابة قد تشكّل ملاذًا ومتنفّسًا للتّحرّر من الإحباط والمعاناة، وتشحن النّفس بطاقة من الأمل والتّفاؤل والثّبات.
– الكتابة كرسالة لإحداث تغيير إيجابيّ وتحقيق حياة أفضل.
– الكتابة تمنح الشّعور بتحقيق نوع من الاستمراريّة والخلود!
العوامل والمصادر الّتي تأثّرتُ بها والّتي أثْرَت كتاباتي:
- الإقبال على المطالعة الذّاتيّة الحرّة منذ المراحل المبكّرة؛ في المدرسة الابتدائيّة والثّانويّة والجامعيّة وحتّى اليوم. وتتوزّع قراءتي المكثّفة لموادّ متنوّعة مثل: القرآن الكريم والحديث النّبويّ الشّريف، روايات وقصص ومسرحيّات، قصائد وأشعار، كتب في النّقد واللّغة وفي التّربية وعلم النّفس والفلسفة …
– الإقبال على ممارسة الكتابة والمثابرة عليها منذ عهد التّعلّم في المرحلتين الابتدائيّة والثانويّة وحتّى اليوم.
– التّعلّم والدّراسة والرّعاية والتّوجيه.
– الميل الفطريّ والموهبة الطّبيعيّة للكتابة والتّعبير
مراحل ومحطّات في تجربتي الكتابيّة:
- المرحلة الأولى (في المدرسة، خاصّة الثّانويّة):
تمتاز كتاباتي في هذه المرحلة بما يلي:
– الميل إلى الاقتباس – في المضمون والأسلوب – بتأثير المطالعة الخارجيّة.
– تزيين وتطعيم الكتابة بكلمات وتعابير كلاسيكيّة عالية، نحو: «إنّ اللهَ ذرأ النّاس وأسكنهم الغبراء الواسعة…». (من موضوع إنشاء كتبتُه في الصّفّ الثّامن!)
– استعمال الزّخرف اللّفظيّ، خاصةً أسلوبَ السّجع، نحو: «… والمكان الّذي يطيبُ للمرءِ لنفثِ آلامه المُضنية هو الطّبيعة؛ بهوائها البليل، ونسيمها العليل، ومروجها الخضراء، وحدائقها الغنّاء، ذات الحسن الوضّاء، والرّونقِ والبهاء…» (في موضوع إنشاء كتبتُه في الصّفّ العاشر!).
- الميل إلى تضمين أبيات من الشّعر في الكتابة لدعم الفكرة المطروحة، نحو:
«… لذا أحبّذ إنشاء المدارس على المستشفيات؛ لأنّ المدرسة هي دواءُ الجهل والفقر والمرض، ولأنّ العلم فريضةٌ على كلّ مسلمٍ ومسلمة، وشرفه فوق شرف النسب، ولا يعدلُه مالٌ أو جاهٌ، فقد قال الشّاعرُ:
يا جامعَ العلمِ نِعمَ الذّخرُ تجمعُهُ – لا تعدلنَّ به دُرًّا ولا ذهبا». (من موضوع كتبتُه في الصّفّ الحادي عشر)
– بداية إبداء الآراء والأفكار الذّاتيّة والقيم الحميدة بصورة جليّة ملموسة، نحو: «… هدفُنا من الحياة ليست الحياة نفسها، ولكن الحياة لما فيها من العبر، ولما فيها من الحِكَم، ولما فيها من الجمال، ولما فيها من اتّحاد وتآلفِ القلوب. هدفنا أن نُفيد ونستفيد كما عمل أجدادُنا أسلافُنا، وكما سيعملُ الخلفُ…» (من موضوع كتبتُه في الصّفّ الثّاني عشر)
- مرحلة التّحرّر من الاقتباس والكتابة الأكاديميّة الموضوعيّة:
في هذه المرحلة حرصتُ على الالتزام بالأسلوب العلميّ الموضوعيّ البعيد عن الزّخرف والتّعبير العاطفيّ، والأنواع التي كتبتُها تشمل:
– أبحاثي ودراساتي الجامعيّة، الأبحاث والكتابات التي كتبتُها في أثناء عملي في التّفتيش والمناهج الدّراسيّة، نحو: (3 كُتب المرشد للمعلّمين في تدريس الأدب العربيّ والعالميّ للإعداديّة وللثّانويّة، كتابي: “القصّة الواقعيّة للأطفال في أدب سليم خوري”، الأبحاث والمقالات – بالعبريّة -عن المناهج وغيرها..).
– مقالاتي ودراساتي في التّربية والمطالعة والنّقد الأدبيّ خاصّة حول أدب الأطفال.
- مرحلة الانطلاق في عالم الإبداع الأدبّي:
في هذه المرحلة – والتي تتداخل مع المرحلة السابقة زمنيًّا – أخذتُ أكتب، بغزارة نسبيّة، النّصوص الأدبيّة الإبداعيّة والّتي شملت:
– الخاطرة الذّاتيّة.
– القصّة القصيرة للكبار وللأطفال.
– قصّة الومضة (القصيرة جدًّا).
– أدب السّيرة الذّاتيّة.
– المقالة الأدبيّة.
– المذكّرات وأدب الرّحلات.
(ملحوظة: من الجدير بالذّكر أنّ المراحل المذكورة تتداخل، ومع ذلك هناك سمات غالبة على كلّ مرحلة).
خصائص وسمات بارزة في كتاباتي الإبداعيّة:
في كتاباتي الإبداعيّة أحرص على:
– مراعاة جمهور المتلقّين، فما يناسب الكبار البالغين لا يناسب الأطفال والفتيان.
– مراعاة اللّون الأدبيّ، فأسلوب المقال الأدبيّ يختلف عن أسلوب القصّة أو السّيرة..
- جعل اللّغة والأسلوب تخدم الغاية أو الهدف من الكتابة؛ فاللّغة والأسلوب ليسا غاية منفصلة عن رسالة النّصّ.
- أحيانًا، ألجأ إلى الرّمز أو إلى الدّعابة والسّخرية والمفارقة لإيصال الرّسالة
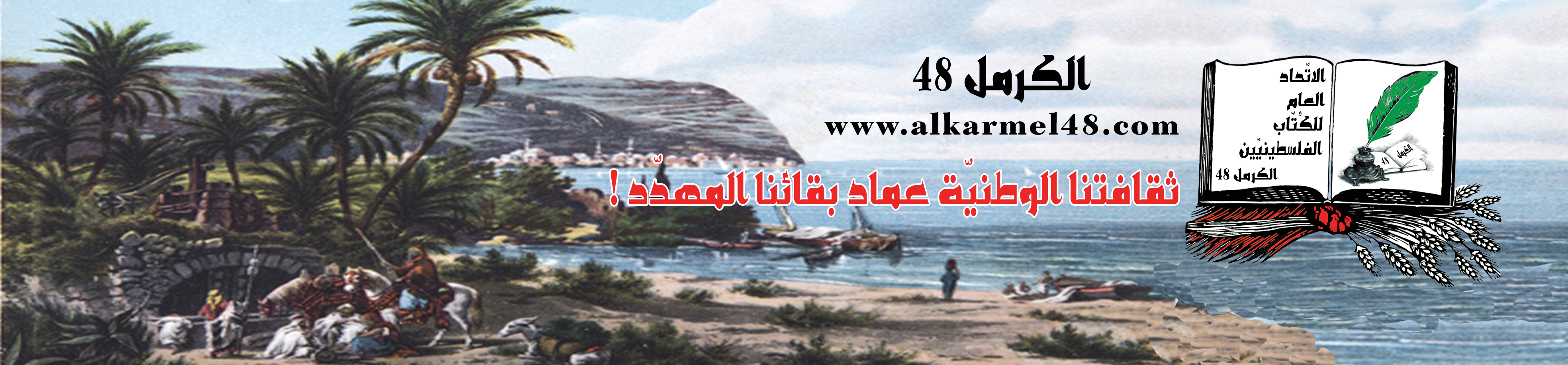 Alkarmel 48 الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48
Alkarmel 48 الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48