“المحاربون من الجانبين يقولون كلامًا متشابهًا
بحضرة من يُحِبُّون. أمَّا القتلى من الجانبين،
فلا يدركون إلّا متأخرين، أنّ لهم عدوًّا
مشتركًا هو: الموت. فما معنى ذلك”
(محمود درويش، عدوّ مشترك، أثر الفراشة)
مدخل
اسم الرواية “يس” للروائيّ أحمد أبو سليم تحكي عن قرية دير ياسين المهجّرة وعن مجزرتها، عمّا قبلها وعمَّا بعدها. نرى بالاسم تعبيرًا يرمز إلى فلسطين كاملة؛ فدير ياسين هي جزء من فلسطين، فالمجزرة تعبيرٌ يرمز إلى النكبة، فمنها كانت بداية النكبة. ونتساءل هل هي رواية تاريخيّة تتحدث عن حكاية القرية بتفاصيل دقيقة، وتذكر أسماء شخصيّات حقيقيّة ومواقع حقيقيّة، وأحداثًا حدثت فعلًا من أجل توثيقها لتبقى للذكرى والتاريخ؟ وبالإضافة إلى هذا هل نجد تأمّلات الراوي وأفكاره وتَخَيُّلاته لأحداث متخيَّلة، فهي أسلوب ضروريّ ومن متطلّبات إتمام العمل؟ الكاتب أحمد أبو سليم يوضّح هذا الأمر في مقابلة أجرتها معه هدى الدلو (16 مايو 2022): و”يوضح أنّ كونه أَمام مجزرة حقيقيّة فلا يمكن أن يقفز عن الواقع، “أَعني التاريخ”، لذا كان الفصل الأوّل استعراضًا لتفاصيل المجزرة الدقيقة، وهو محاولة للخروج من التجريد الّذي يصاب به العقل البشريّ مع الزَّمن”، وتضيف هدى الدلو أنّ الرواية جزء من مشروعه الّذي يتحدّث عن الأوضاع الفلسطينيّة ومأساتهم، ومسارات تلك القضيّة، يقول أبو سليم: “ما يميِّز هذا المشروع باعتقادي أنّه لا يأخذ الوقائع كمسلّمات بقدر ما يحاول أَن ينبش في ما وراءها، أي محاولة لتسليط الضوء برؤية فلسفيّة على التفاصيل الّتي ربّما لا ينتبه إليها الكثيرون، وإعادة دراستها ضمن المنطق الرِّوائيِّ-الفلسفيِّ، وما يسمح به فنيًّا”. نعتقد أنّ الكاتب يؤكّد هذا بقوله: “هل يمكن للذَّاكرة أَن تصاب بالصَّدأ، وتهترئ؟”(الرواية، ص 9، السطر الأول). والتاريخ والذاكرة رفيقان، ولماذا إذن يخاف ” الغُزَاةِ مِنَ الذِّكْرياتْ” (محمود درويش، على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة).
“يس” لأحمد أبو سليم-الحكاية
هي رواية تتأرجح بين الواقع وتيّار الوعي. الواقع يدور حول أحداث قرية دير ياسين، المهجّرة قضاء القدس، ويسرد الراوي تفاصيل المجزرة الّتي ارتكبها الاحتلال في 9.4.1948 ومنها، كما يقول الراوي، الطفل ياسين، الّذي ولد قبل المجزرة بثمانية أَيَّام: “انطلقت شرارة الحرب، أعني 1948، كانت دير ياسين بداية البداية” (الرواية ص 14)، هي بداية النكبة حيث يسردها الراوي المتكلّم بضمير الأنا والعليم. يسرد الراوية وكأنّه موجود في المكان ومشاهدٌ للأحداث، هذا بالإضافة إلى ما سَردته له والدته وغيرها، وبوساطة تأمّلاته وأفكاره وتساؤلاته، هكذا أصبح شاهدًا على المجزرة ممّا تعَلَّمه وتأمّله.
سرد الراوي الاتجاهات الّتي حوصرت منها القرية، والعمليّات العسكريّة، وأسماء الكتائب العسكريّة الّتي هجمت على القرية، مثل “الهاغناة” و”ليحي” وغيرها وأسماء القادة، وأكثر من ذلك، فالراوي العليم يعرف حتّى الخطّة الاستراتيجيّة تجاه القرية ” كانت الخطَّة تقضي بمحاصرة القرية تمامًا من كلِّ الجهات، وإبادتها بكلِّ من فيها، ببشرها، ودوابِّها، وطيورها، وحشراتها، وكلِّ ما يتنفَّس فيها، كانت جزءًا من عمليَّة “نحشون” الّتي خطَّطت لها الهاغاناه، لذا انقسم المهاجمون إلى أَربع مجموعات” (الرواية، ص 16-17).
البِنية الروائيّة
1. النصوص الموازية: العنوان والأغلفة والإهداء ونبذة عن الكاتب وصفحة الحقوق (Credit) وتفاصيل النشر والإيداع وغيرها.
2. الاستدارة / الدائرة المغلقة / الحبكة الدائريّة. أسلوب بناء تقنيّ للإنتاج الأدبيّ حيث يبدأ الكاتب بأمر معيّن ثمّ ينهيه بنفس الأمر، وأحيانًا بنفس الجُمْلَة أو المقطع، يسمّى هذا الأسلوب عند البعض “الدائرة المغلقة” وهو مبنى دائري (Inclusio). بدأ الكاتب الرواية وأغلقها في دائرة مستديرة، استهلّها ب “مجزرة دير ياسين” وأنهاها بمجزرة “صبرا وشاتيلا”، وكأنّ الكاتب يريد حماية الذاكرة بإغلاقها كي لا ننسى. هنالك إمكانيّتا تفسير: الأولى هي أنّ الحكاية لم تنتهِ، وعمليًّا ربّما تعود وتتكرّر مثلما تكررت مجزرة دير ياسين بمجزرة صبرا وشتيلا وغيرها. والثانية في هذا المبنى ما يُلاحَظ في انعدام المخرج من الحالة المطروقة، وربّما هي حالة اختناق. هكذا يترك الكاتب للمتلقّي القرار ووضع خاتمة تناسبه. (انظر، فراس حج محمد، 2024).
يجدر بنا الإشارة إلى تقنية الفسحة الّتي يأخذ فيها المتلقّي فسحة تنفيس ليتحرّر من المخاوف والأفكار والذِّكريات حيث ينتج عنها التخفيف من التَّوتُّر والقلق، وبالتالي يستعيد قدرته الطبيعيّة على متابعة القراءة. وردت هذه الفسحة في منتصف الرواية/ مركز الدائرة تمامًا في (ص 111 – 123) وهي قصّة فتحية الّتي رحل زوجها ولم يعد.
3. متن الرواية: تتكوّن الرواية من خمسة فصول: المجزرة (9-76)، المخيَّم (79-123)، السِّجن (129-172)، الخال (175-220)، الصورة (223-244):
الفصل الأوّل، المجزرة: الأجواء السائدة هي الموت، الرصاص والبارود والدم وصراخ الأطفال والنساء، والبحث عن مخبأ وغيرها. تجدر بنا الإشارة إلى أنّ لمجزرة دير ياسين حضورًا في كل فصول الرواية وكأنّها خيط يبدأ من الفصل الأوّل، المجزرة، ويخترق الفصول الأربعة الأخرى ليربط عقدة مع مذابح صبرا وشتيلا.
الفصل الثاني، المخيَّم: يقع في الزرقاء مدينة المهاجرين، وهو تحصيل حاصل للمجزرة. “الناس كانوا مذهولين، لم يكن ثمَّة منهم من يستوعب ما جرى، كانوا ينتظرون انتهاء الحرب كي يعودوا إلى بيوتهم في فلسطين، انتظروا طويلًا، والحرب أصبحت هدنة بين الطرفين …” (ص 79). وللمجزرة مكانتها الخاصّة في المخيَّم، من خلال التذكُّر، فيحدثنا الراوي عن سهرته مع والدته: “المجزرة كانت حكايتنا الَّليليَّة الّتي لا تنتهي أبدًا. كانت تتذكَّر كلَّ شيءٍ، كلَّ التَّفاصيل، كلَّ البيوت وساكنيها فردًا فردًا، والأشجار، والطُّرقات، والسَّناسل، والمقبرة ومن فيها، والمحاجر، والكسَّارات، ومدرسة الذُّكور، والإناث، والمسجد، والبئر، والكبَّانيّات” (ص87)، فالذّاكرة لا تصاب بالصَّدأ، وتهترئ، فهي كما يتساءل الراوي “انتقائيّة تُخّزِّن أحداثًا بعينها، تراكمها، لتشكل فيما بعد حقيقة هُويّتنا (ص 9). هكذا أصبحت دير ياسين أكثر حضورًا عند غيابها، فالغياب يُحَوِّل الغائب إلى ذكرى حاضرة في الإدراك، وهذا يجعلها أكثر قوّة وعظمة. و”غياب الموضوع، حسب هايدغر يؤكّد وجوده أوّلًا، فهو غائب. كما يحشره بالقوّة في خانة، ما لا يُقَل، وهو كذلك لكونه، غير موجود.” (مصطفى، موقع فسحة، 28.11.2022).
اهتمام خاصّ من الراوي (ص 111-125) حصلت عليه فتحيّة، هي “لم تكن عاهرة تمامًا، كانت انتقائيّة، مزاجيّة، تعطي جسدها لمن تريد، وتحرِّمه على من يريد، خصوصًا أزواج صديقاتها، وجاراتها، والأنكى، أنَّ أكثر المال كان يأتيها من هؤلاء الّذين تمارس الحرمان تجاههم” (ص 119). لم نستغرب وجود الحالة، ولكن نعتقد أنّ موقعها في منتصف الرواية يشير إلى مكانتها السرديّة، فهي تقنيّة لإعطاء المتلقّي فسحة من الراحة لتجديد قواه من أجل الاستمرار في متابعة الأحداث.
الفصل الثالث، السجن: ينتسب الراوي إلى حركة فتح مباشرة بعد حرب الكرامة، وقد اختار الاسم الحركيّ “أمين” ليسجّل في بطاقته العسكريّة، اختاره لا شعوريًّا على اسم أخيه التوأم الّذي استشهد في المجزرة: “رغبة الأَحياء في إيقاظ الموتى من موتهم لا تتوقَّف، نعيدهم حين نسمِّي أَطفالنا بأَسمائهم، أَو حين نطلق أَسماءهم على الشوارع، والمعالم البارزة، أَو حتَّى نبني للمشاهير منهم المتاحف، ونحتفظ ببعض مقتنياتهم فيها … وكأنّها رغبة دفينة في أعماقي فارت، وخرجت فجأة إلى السَّطح، شيء ما في أعماقي حاول سحبه إلى الأعلى، ليعود فوق السور ..ويفتح عينيه ويضحك”” (ص 130). المهنة: مقاتل، هذا كان تعيينه ولكنَّه طُرد مرتين من المعسكر لأنّه لا يصلح أن يكون مقاتلًا وذلك بسبب الورم في رأسه لم يكن دقيقًا في التصويب.
وتعود وتظهر فتحيّة ثانية، ولكن هذه المرّة مختلفة، فقدت أنوثتها ولم يعد يهتمّ أحد بها، واستشهد ابنها وبدأت تبحث عن زوجها الّذي اختفى وأصبحت كالمجنونة. لقاء الراوي مع نهرو كان سببًا لاتهامه بالشيوعيّة ودخوله السجن.
الفصل الرابع، الخال: خالي مات، هي بداية الفصل. الخال ياسين الّذي سُمّيَ الراوي على اسمه ترك له صندوقًا يحتوي على أغراضه: أوراق، وثائق، قواشين ملكيّة، وثيقة زواجه من ياسمين، صورته مع ياسمين وأوراق مختلفة غيرها. في هذه الأوراق حضرت المجزرة بشكل قويّ ومُكّثَّف، أكثر من ثلاثين صورة للمجزرة، وفيها نلتقي مع رسائل “حنا نوسين” الصحفيّة إلى الخال، وفي رسائلها تكتب عن المجزرة (180-190). هي نوسين الّتي عبّرت عن امتعاضها من أقوال “شراغا”، رجل الأمن في جهاز الهاغاناه. حنا نوسين أحبَّت الخال ياسين عندما شاهدت “وأدركت أنّه جاء إلى الموت بقدمَيْه من أجل إنقاذ حبيبته” وفضلته عن شراغا قائلة له “هل يمكن أن تفعل مثله وتأتي لتنقذني من الموت لوكنت مكانه”(ص 64، 65) وصرَّحت بذلك لأختها سيرينا المقيمة في لندن عندما زارتها وقدَّمت التماسًا للحكومة كي يسمحوا لها باصطحابها إلى لندن ورعايتها، لكنَّ الحكومة رفضت بحجَّة أنَّها مواطنة اسرائيليّة مريضة، وأنّ الدَّولة مسؤولة عنها، ولكنّ السبب الحقيقيّ خوف الحكومة من نشر نوسين لحقائق المجزرة، وهنا أخبرت سيرينا أنّها “متعلّقة برجل عربيّ هو من تبقَّى من المذبحة” (ص 206). المثير في هذا الفصل اللّقاء بين الخال ياسين وبين درور ابن نوسين، الّذي قال عن نفسه إنّه مجهول الأب وأمّه تُصرّ على إخفاء السرّ، وكان يعتقد أنّه ابن الخال ياسين. ولاحقًا أصبح درور مجنَّدًا في جيش الدِّفاع، ما يذكّرنا برواية غسان كنفاني “عائد إلى حيفا”.
الفصل الخامس، الصُّورة: نهرو الطبيب أقنع الراوي ياسين بإجراء فحوصات طبيّة تمهيدًا لإجراء عمليَّة جراحيَّة في موسكو، مجانًا، كمنحة من الحزب، نتيجة الفحوصات كانت: “ستشوِّه العمليَّة وعيه تمامًا” وقال الطبيب “أحضرت له أدوية توقف تَمدُّد الورم في رأسه” (ص 224). يعود في هذا الفصل ويلخّص الرواية: مسك بيده صورة خاله ياسين وصورة زوج فتحيّة واستنتج أنّ “الصُّور تخدعنا وتكمن فيها عبقريّة في أنَّها قادرة على الإمساك بلحظة زمن، تُجَمِّدها، لتعود إليها متى شئتَ، وتعود استحضارها في ذهنك، الصُّور مجرَّد دليل، لكنَّها كذبة أيضًا” (ص 227). ويغلق الكاتب الرواية في دائرة مستديرة، استهلها بـ “مجزرة دير ياسين” وأنهاها بمجزرة “صبرا وشاتيلا”، معلنًا: “ثمَّة بائع صحف ظهر فجأَة داخل المشهد وهو يصرخ: مذبحة في صبرا، وشاتيلا، اقرأْ أَخبار المذبحة، رأي، دستور، رأي، دستور ” (ص 243) ونقول: هل نحن بحاجة إلى مزيد من المجازر لندرك أحوالنا؟
ما مدى صحَّة القول الّذي نردِّده: “اللي بشوف مصيبة غيره، بتهون مصيبته”؟ هل مصيبة دير ياسين ليست مصيبة صبرا وشتيلا. كلّها مجازر فلسطينيّة المصيبة مصيبة، والألم ألم، والحزن حزن، والنكبة نكبة واحدة هذه مصائب تجتاح وتؤلم الجميع.
النصوص الموازية:
العنوان:
“يس” مُكَوَّن من حرفين: “ياء” و”سين” وتُلفظ بالمحكيّة “يا” و “سين” وهو اسم “دير ياسين”. هكذا وضع الكاتب اسم المكان، قرية “دير ياسين” بمكانة قداسة، وهنا نُعَرِّج على سُورَةِ “يس” في الْقُرْآنِ الكريم، وَالّتي تُقْرَأُ يَا سِين. (حسب معجم: اللغة العربية المعاصر).
برزت هذه المكانة في المتن عندما رأى الراوي هول المجزرة، قائلًا بغضب شديد: “لم ينفع البكاء، ولا العويل، ولا النَّحيب، ولا التوسُّل ولا الرجاء، ولا التضرُّع ولا سورة يس”، وينقل الآية التاسعة “وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ” (ص 29، 30). تكرّرت هذه الآية بصوت أمّه لحمايته من الجنود في الفصل الثاني (ص 108) وتكرّرت مرّة أخرى بصوته بجانب قبر أمِّه الّتي مضى على موتها عام وفي كلّ يوم خميس كان يزور قبرها ويقرأ الآية ذاتها من سورة “يس” (ص 135)، وتعود وتظهر مرّتين في المحادثة بين الراوي ونهرو (ص 154).
تُقرأ هذه الآية لقضاء الحوائج وللشفاء من الأمراض والعلل وذلك بقراءتها بالنحو التالي: بعد الاستعاذة والبسملة تقرأ (يس –يس-7 مرات) ثم تدعو بعدها ثمّ تقرأ الآيات الأولى وتدعو بعدها. وعندما تصل نهاية آيات معيّنة في السورة هناك دعاء وحمد وتمجيد لله تعالى. قال النبيّ صلى الله عليه وسلّم: “اقرءوا يس على موتاكم ما من ميت يقرأ عليه سورة يس إلّا هَوَّن الله عليه”. وقال: “إنّ في القرآن لسورة تشفع لقرائها ويغفر لمستمعها، ألا وهي سورة يس، وهي تدفع عن صاحبها كلّ سوء، وتقضي له كلّ حاجة”.
وأكّدت دار الإفتاء المصريّة، عبر موقعها الرسميّ أنّ قراءة سورة “يس” بهدف قضاء الحاجات وتيسير الأمور جائزة شرعًا، لما لها من فضل وثواب عظيم. وقد رأى فريق من العلماء أنّ سورة “يس” يمكن قراءتها بنيَّة تحقيق الرزق، وتفريج الكربات، وسداد الديون، وغيرها من حاجات الدنيا، شريطة أن يكون القارئ موقنًا بقدرة الله على قضاء حاجته.
سورة “يس” تعَُدُ من السور المباركة، الّتي تجلب للقارئ البركة وتحقق له الطمأنينة، وذلك بحسب فضلها الّذي ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم، فهي تُقرأ كذلك على الموتى، حيث جاء الأمر بقراءتها كنوع من الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة. “حكم قراءة سورة يس لقضاء الحاجات” (موقع المصري اليوم 14.11.2024)
“دير” انتشرت كلمة دير في تسمية القرى الفلسطينيّة، خاصّة قرى القدس الّتي اشتهرت بطابعها الدينيّ. وهو مبنى عبادة لدى بعض الديانات كالبوذيّة والمسيحيّة، يُستخدم للعبادة والتأمّل. وتعود أصل تسمية الكلمة في اللّغة العربيّة إلى الآراميّة حيث تعني كلمة الدير “مزرعة”، أو “بيت الفلاح” نسبة إلى طريقة معيشة النسّاك الأوائل من اليهود والمسيحيّين.
لوحة الغلاف
صورة من مجزرة دير ياسين مشحونة برموز دلاليّة متعدّدة لامرأة تحمل طفلها بذراعيّها وهو متمسّكٌ بها منذهلٌ وخائفٌ كأنّه يرى أمرًا مخيفًا، وواضعًا يده على صدر أمّه الّذي أرضعه ويرى به مصدر الأمان والطُمَأْنينة، باحثًا عن حالة من الهدوء وعدم وجود خطر. والأم أتعبتها مشاهد القتل وألمُ الفراق والهدم، ملامحها مؤلمة جدًّا، وتبدو صرختها في البريّة ولا حياة لمن تنادي. اللّون السائد في الصورة؛ هو اللّون البنيّ وبعض البقع السوداء. البنيّ من الألوان المُحايدة الّتي تُشير إلى الاستقرار والأمان والقيم الراسخة، حيث إنّه لون الأرض الثابتة. ولكن في هذه اللّوحة على الرغم من المشاعر الإيجابيّة الّتي ورد ذكرها من قبل، إلّا أنّ استخدامه خاصّة بصبغته الداكنة جدًّا يعمل هنا بشكلٍ عكسيّ، ويوحي بمشاعر قاسية تدلّ على الوحدة والحزن والعزلة، خاصّةً وجود بعض البقع السوداء الّتي تدلّ على الحزن والموت والخوف والحداد. نراها أيضًا واضعةً كفَّ يدها على خدِّها محاولةً بذلك إخفاء صرختها كي لا تُذهل ابنها ولا يكتشف عدوُّها مكانها.
الإهداء
خصّص الكاتب الإهداء إلى شهداء دير ياسين، وإلى من يسيرون الآن عائدين إلى فلسطين، هذا الإهداء يدلّ على إيمانه بالعودة للشهداء والأحياء، هذا ما نشأ عليه وظهر في طلب والدته: “أمسكتْ بكفّي، قبضت عليها بقوَّة لم أعهدها فيها من قبل، حدَّقت في عينيَّ: إن متُّ قبل أَن تنتهي الحرب ونعود، إيَّاك أَن تدفنني في المخيَّم، احمل جثَّتي مع الأَمتعة، ادفع دينارين أَو ثلاثة دنانير أُخرى لسائق الشَّاحنة، وادفنِّي في فلسطين”(ص 136).
الغلاف الخلفي
يحتوي الغلاف الخلفيّ على تظهير بقلم مراد السودانيّ، الأمين العامّ للاتحاد العامّ للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، يشيد بكلمته برواية أحمد أبو سليم. نجد أيضًا نفس لوحة الغلاف الأماميّ ويبرز أيضًا المؤسسات الداعمة لإصدار الرواية: وزارة الثقافة الفلسطينيّة، وبيت لحم عاصمة الثقافة الفلسطينية.
الشّخصيّات:
تقسّم الشخصيّات في العمل الروائي إلى ثلاثة أنواع: الشخصيّة الرئيسيّة، والشخصيّة الثانويّة (عساقله ومرعي، 2024، ص61-62) والشخصيّة الهامشيّة الّتي يعتبرها البعض ثانويّة ولكنّها أقلّ حضورًا من الثانويّة، فتظهر في حدث عابر أو اثنين وتقوم بدور هامشيّ، في حدث معيّن، أو موضوع محدّد، أو غرض عَيْنيّ (أدْهوك Ad hoc) وعند عساقله ومرعي يُطلق عليها اسم الشخصيّة الثانويّة.
ومن حيث ارتباط الشّخصيّات بتطوّر الأحداث، تُقسم الشّخصيّات إلى ثلاثة أنواع:
الشخصيّة النّامية هي شخصيّة تتطوّر من موقف لآخر.
الشخصيّة الثّابتة وهي الشخصيّة الّتي تُبنى حول فكرة واحدة، لا تتغيّر طوال الرواية.
الشخصيّة النّموذجيّة (النّمطيّة) هي الشخصيّة الّتي يرسمها الروائيّ بوصفها ممثّلة لطبقة من الطبقات أو لجيل من الأجيال، ليبرّر فيها اتجاهات تلك الطبقة، أو ذلك الجيل، أو سماتها الـمميّزة (عساقله ومرعي، 2024، ص 63-64).
الشّخصيّات في رواية “يس”:
الراوي ياسين: شخصيّة رئيسيّة، المولود قبل المجزرة بثمانية أَيَّام في أوَّل نيسان، وسمَّته والدته على اسم شقيقها الّذي اعتقدوا أنَّه استُشهد، وكان يحمل بعضًا من صفاته ممّا جعله مكمِّلًا لدوره، وملتزمًا بقضايا دير ياسين وأهلها، وكما يقول المثل العربي “ثلثين الولد لخاله”.
كان الناجي الوحيد من بين الأَطفال الّذين قُتلوا في المجزرة، وتبيّن أنه مصابٌ بورم في الدماغ يجعله يرى الأَشياء بالمقلوب، ما يشكّل لديه وعياً مختلفاً عن الآخرين. انتمى إلى حركة فتح باسم حركي “أمين”، على اسم توأمه الّذي استُشهد في طريق الهروب من دير ياسين “رغبة الأَحياء في إيقاظ الموتى من موتهم لا تتوقَّف نعيدهم حين نسمِّي أَطفالنا بأَسمائهم، أَو حين نطلق أَسماءهم على الشَّوارع، والمعالم البارزة، أَو حتَّى نبني للمشاهير منهم المتاحف، ونحتفظ ببعض مقتنياتهم فيها”. (ص 130) ولكن بسبب الورم الدماغيّ، يقول: “طردوني من المعسكر مرَّتين … لم أكن صالحًا للحرب (ص 132، 134).
الخال “ياسين” خال الرَّاوي “ياسين”، شخصيّة رئيسيّة أخرى: الخال ياسين كان مناضلًا، ملتزمًا، جريئًا، أحبّ ياسمين الّتي طلبت أن يكون مهرها قتل قاتل أبيها “وليام جاك”، وقد تمكَّن بالفعل من قتله ليحوز بذلك على رضاها والزواج منها. “أن يكون مهري حياة وليم جاك، الضَّابط الإنجليزي، ولا أريد مهرًا سواه”(ص 46). بعد ثلاثة أسابيع تزوَّجا، وبعد عام بالضبط من زواجهما وقعت المجزرة. وكان الخال آخر الشهود على المجزرة، لكنَّهم قطعوا لسانه كي لا يروي حكاية المجزرة، كما قال يوشع لشراغا: ” لا نريدُ شهودًا على ما جرى” (ص 70). لشدة حبّه لياسمين أحبّته الصحفيّة نوسين (ص 65). محاولة الخال ياسين إنقاذ ياسمين من المجزرة ترمز إلى إخلاص الفلسطينيّ. نعتقد هذا ما أراد قوله الكاتب: “أحيانًا قد يكمن الوطن كلُّه في امرأة، قد تصبح فلسطين هي ياسمين، وتصبح ياسمين فلسطين (ص 55).
ياسمين: شخصيّة ثانويّة. يشيد الراوي في عدة مواقع في الرواية بجمالها، مثلًا: “ياسمين زوجة خالي أجمل امرأة في فلسطين” (ص 41). امرأة وطنيّة كانت تشارك في المظاهرات وتحتجُّ على السِّياسة الإنجليزيّة تجاه فلسطين، والتقت مع ياسين حين حماها عندما تعرّضت للضرب، وتزوّجا بعد أن حقّقّ مهرها الّذي طلبته وهو قتل “وليام جاك” الّذي قتل أباها. وقتلت في المجزرة.
حنا نوسين: شخصيّة ثانويّة، أحبّت ياسين عندما رأت شدّة حبِّه لياسمين، وتماهت مع قضيّته، كانت نهايتها بأن عاقبوها بوضعها في مشفى للأمراض العقليّة. “حين حاولت فضح الأمر ذات يوم أمام مجموعة من الصَّحفيِّين ألقَوْا القبض عليها وهي تعدُّ لذلك اللّقاء، اتّهموها بالجنون، وأودعت مشفى كفار شاؤول النفسيّ، وفي ملفِّها الطبيِّ كتبوا أنَّ لديها عوارض ذهان وجنون وارتياب، وأنَّها لا تدرك مرضها” (ص 204).
شَّخصيّات هامشيّة: هي أقلّ حضورًا من الثانويّة، فتظهر في حدث عابر، أو اثنين، وتقوم بدور هامشيّ: الأمّ، الجدّ، سيرينا نوسين (أخت حنا نوسين)، فتحيّة، حامد عبد الفتَّاح، نسرين، نهرو، أمين، أحمد عبد الفتَّاح، لطيفة شراغا، يوشع، وليم جاك، درور، مردخاي، منسيه ايخلر، يهودا سيفل ويهودا لبيدوت.
اللّغة والأسلوب السرديّ:
لغة الرواية سهلة وسلسة، وقلّما نجد كلمة غير مفهومة، فهي مكتوبة بلغة أيّامنا، لا ترهق المتلقّي، إنّما تجذبه وتساعده في التركيز وسلاسة التفكير ممّا يؤدي إلى استمتاعه فيسهّل اختراقَه للنصّ والتعايش معه، نحن ندعم هذا؛ لأنّ رسالة الكاتب في هذا الأسلوب تصل إلى المتلقي وتحقّق أهدافه. يطالب البعض من الكتاب غير ذلك ممّا يؤدي إلى ابتعاد الناس عن القراءة، وتكون خسارتنا الثقافيّة كبيرة. تنوّعت طُرق السرد فيها: السرد بضمير المتكلّم والعليم، والاسم الدليل، والتكرار التفصيليّ، والتكرار التفصيلي بأسلوب الفصل، والحوار الداخليّ (الـمونولوج)، والحوار الخارجيّ، والثنائيّات الضدّيةّ، وهكذا نجح الكاتب في نقل حكاية المجزرة، وتصوير الشّخصيّات والأماكن تصويرًا واقعيًّا ومثيرًا.
يسرد الراوي المتكلّم بضمير الأنا والعليم، وكأنّه موجودٌ في المكان ومشاهدٌ للأحداث، وممّا سَردته له والدته وغيرها، وبوساطة تأمّلاته وأفكاره وتساؤلاته؛ هكذا أصبح شاهدًا على المجزرة ممّا تعَلَّمه وتأمّله، أمثلة:
الراوي المتكلّم: “كلّما شعرتُ باكتظاظ في الذّاكرة شعرتُ بقوة هائلة تضغط جدران رأسي من الدَّاخل فيكاد ينفجر” (ص 11).
“تركتُ الصَّلاة، وخرجتُ، أطلقتُ ساقيَّ للريح، عدتُ إلى البيت” (ص 124).
الراوي العليم: “كانت الخطّة تقضي بمحاصرة القرية تمامًا من كلِّ الجهات، وإبادتها بكلِّ من فيها، ببشرها، ودوابِّها، وطيورها وحشراتها، وكلِّ ما يتنفّس فيها، كانت جزءًا من عمليّة “نحشون” الّتي خطّطت لها الهاغاناه، لذا انقسم المهاجمون إلى أربع مجموعات” (ص 16).
تجدر بنا الإشارة إلى أنّه عندما تحدّث الراوي عن نفسه استخدم ضمير المتكلّم (أنا)، وعندما تّحدّث عن سلوك الآخرين استخدم الضمير الملائم (ذاك أو هو أو هي، هم، نحن وغيرها). “خالي كان (هو) آخر الشهود على المجزرة لكنَّهم قطعوا لسانه” (ص 59).
“كانت (هي) تتذكّر كلَّ شيء، كلّ التفاصيل، كلّ البيوت وساكنيها، والأشجار …” (ص 87).
الاسم الدليل (Apotronym) وهو كما نقول “اسم على مُسمّى” يختار الكاتب اسم، غالبًا لحاجات أخلاقيّة للحثّ على التمسّك بالأخلاق الحميدة، أو للتهكّم وحتّى للسخرية اللّاذعة، أو لإبراز وتأكيد أمر معيّن (أوخماني الجزء الأول، 1979، ص 70). يعتبر البعض هذا الأمر سلبيًّا؛ لأنّ الكاتب فيه يحدّد سلفًا صفات وسلوك ومصير الشّخصيّة، وهم يفضّلون أن يستنتجها المتلقّي خلال قراءة النصّ الأدبيّ وبعده، ويَدَّعون أنّ حبكة الاحداث وتطوّرها جاءت كي تؤكّد الاسم كما حدّده الكاتب سلفًا. ومن ناحية اخرى يحبّذ الكثيرون هذا الأسلوب، وكثيرًا ما يميِّز إنتاجهم، ومنهم، مثلًا، حنا مينة في روايته “نهاية رجل شجاع” اسم بطل الرواية “مفيد الوحش” (لأنّه قطع ذيل الجحش) بسبب رهبته. و”عبدوش الداشر” لأنّه كان داشرًا/ شاردًا/فارًّا من الجيش الفرنسيّ.
في رواية “يس” الموضوع الأساس هو مجزرة دير ياسين وأحوال أهلها، وسمَّى الكاتب روايته بـ “يس” تيمّنًا بسُورَةِ “يس” في الْقُرْآنِ الكريم لإعطائها هالة قداسة، وقد استحضر الكاتب سورة “يس” في عدّة مواضع في الرواية، مثلًا: “شيء ما، غريب، عاطفة لا أستطيع تفسيرها تربطني بسورة يس…وجعلنا من بين أيديهم سدًّا، ومن خلفهم سدًّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون” (ص 101). والاسم الدليل في الرواية هو “ياسين” (اسم القرية والسورة والرواية) ونجد جميع الأسماء مرتبطة به: ياسين الطفل الرَّاوي، خاله ياسين، حنا نوسين، سيرنا نوسين، نسرين، ياسمين، هذه علاقة غير عاديَّة بين أسماء الشَّخصيّات، ففيها كلّها حرف السِّين، وتأثّر جميعهم بالمجزرة وتفاعلوا معها. ربط الأسماء مع “دير ياسين” ومع سورة “يس” هو دليل على هدف الكاتب أن تكون الأسماء “اسم على مُسمى”، أضف إلى ذلك ما اكتشفه الطبيب نهرو: “متلازمة دير ياسين”، والمتلازمة حسب التعريف الطبيّ هي “مجموعة من العلامات والأعراض الّتي تظهر بشكل مترافق مع بعضها ويدلّ ظهورها مجتمعة على الاصابة بمرض، اضطراب نفسيّ أو حالة شاذَّة (موقع الطبي، 2013). ويقول نهرو: “متلازمة دير ياسين موجودة حتمًا، حتّى لو حاولنا القفز عنها … ولكنَّ أحدًا لا يلتفت إليها …وأعراضها هلوسات، وتعرُّق، وقلق، وذكريات متقطِّعة، وشعور بالرَّغبة بمغادرة المكان، وبعض العيِّنات أصابها شعور بالغثيان” (ص 217). أليست هذه المتلازمة اسمًا دليلًا مثل اسماء الشّخصيَّات المرافقة لاسم ياسين والّتي في الحقيقة تحتوي على مجموعة من السمات، أو العلامات المميّزة الّتي تعمل معًا؟
التكرار التفصيليّ: هو مجموعة كلمات معطوفة على بعضها، فنغمة هذه الكلمات المتكرّرة تبرز إيقاع النفس المنفعلة والدهِشة. وهي أداة يستثمرها الكاتب لتساعده في إضاءة التجربة وإثرائها وتقديمها للمتلقّي لتحريك هاجسه ليتفاعل مع تجربته. في هذا التكرار يوجد إيقاع موسيقيّ، وهو قادر على نقل التجربة وتأكيد المضمون، وهكذا يقوم كلّ من التكرار الصوتيّ والتوتّر الإيقاعيّ بمهمّة الكشف عن القوّة الخفيّة في الكلمة، مثلًا:
“عين هنا، ويدٌ هناك، وقدم، ورأس، وأمعاء، وأشلاء، وأوجاع، وصراخ، وأحلام كانت تتبعثر، وتغتسل بالغبار” (ص 23).
“فتَّش عن جدِّي، وجدَّتي، عن أمّي، وأبي، وعمّاتي بين الناجين، فلم يجد أحدًا منهم، راح يسأل النَّاجين عنهم، فلم يجد جوابًا واحدًا يشفي غليله، ويهدّئ من روعه” (ص 61).
والتكرار التفصيليّ بطريقة الفصل (Asyndeton) وهو الإتيان بكلمات، أو جمل، أو مفردات أو تعابير (أسماء أو أفعال) معطوفة بعضها على بعض بدون أداة عطف، وهو أكثر إيقاعًا وزخمًا (وهبة والمهندس، 1984. ص 274).
“أرافق أُمِّي إلى المؤن، النِّساء يفترشن الأرض بانتظار السَّماح لهنَّ بالدّخول، يُدخلوهنَّ مجموعة مجموعة، يستعرضن فلسطين، قُراهنَّ، تهجيرهن، القتل، والمجازر” (ص 94).
“عشرة أطبَّاء، وطبيبتان كانوا يتحرَّكون بلا توقُّف، يركضون هنا، وهناك، يسألون، يعاينون، يكتبون وصفات طبيّة، يعطون دواء …” (ص 96)
الاسترجاع (الفلاش باك): يفتتح الراوي روايته بـ “هل يمكن للذاكرة أن تصاب بالصدَّأ؟” هذه إشارة من الراوي حول ضرورة الاسترجاع كأسلوب سرديّ سيستثمره. الاسترجاع الزّمنيّ في الرّواية هو انقطاع التّسلسل الزّمنيّ، أو المكانيّ للقصّة، أو المسرحيّة أو الفيلم لاستحضار مشهد، أو مشاهد ماضية، تلقي الضّوء على موقف من المواقف أو تعلّقُ عليه. تتّكئ الرّواية ُعلى التّلاعب الزّمنيّ بين الاسترجاع (الماضي) والحاضر (الآن) فهما تُثيران في نفس المتلقّي المتعة والأنس كما تخلقان رؤيةً جديدةً للحوادث زادَ منَ التّشويقِ ومن متعةِ القارئ (بحراوي، 2016، ص 122). بما أنّ الراوي وُلد قبل المجزرة بثمانية أيام، فيعتمد على سرده الاسترجاعيّ على ما سمعه من أمّه ومن غيرها، ومن تَخَيُّله، أمثلة: “استشهد عبد القادر الحسينيّ في القسطل، وفي اليوم التَّالي، التاسع من نيسان، عام 1948، يوم الجمعة، وقبل أن يُدفن، كان اليهود يتدفّقون إلى دير ياسين” (ص 10). “كانت بيوتنا حسب وصف أمِّي مقابل المسجد تمامًا (ص 12). كان عمر الراوي ثمانية أيام وهو يسرد هذا الحدث مسترجعًا إياه حسب ما تعلَّمه. “رائحة الماضي تختلط بالحاضر، الحاضر يصبح وجهًا من وجوه الماضي، جزءًا لا يتجزّأ منه، قطعة لا يمكن فصلها عنه” (ص 87). هكذا في الاسترجاع تختلط الأزمنة وتتكسّر؛ أي يتجاوز التعامل مع الزمن البعدَ الزمنيَّ التقليديّ، فيُستكشف الزمن بطرق متعدّدة، بما في ذلك التحوّلات والانكسارات، وهذا الأسلوب يتيح استكشافًا أعمق لوعي الشخصيّة حيث يتبدّل الزمن في ذهنها تبعًا للأحداث الداخليّة والأحاسيس النفسيّة؛ فالتداعي الحرّ يُعتبر من سمات تيار الوعي وسيلة للتحوّل بين الزمن، فمن خلال التداعي الحرّ يمكن للشخصيّة أن ترتبط بالماضي، وأن تعيش الحاضر، وأن تتوقّع المستقبل، كلّ ذلك ضمن سريان واحد، وقد يتوقّف الزمن في لحظة معيّنة بسبب حدث مفاجئ، أو صدمة، وهذا ما يترك انطباعًا قويًّا في الذاكرة مع تجسيد الزمن بأكمله في هذه اللّحظة. أمّا القفز الزمنيّ فيمثّل تحوّلًا في الزمن من حدث إلى آخر، مع وجود فاصل زمنيّ بينهما، وهذا ما يتيح للشخصيّة استكشاف عدّة نقاط زمنيّة في آن واحد، وقد يحدث تداخل بين الأزمنة الثلاثة (الماضي، الحاضر، المستقبل) في ذهن الشخصيّة حيث يخلق ذلك إحساسًا بالضبابيّة أو التعقيد في الزمن، وقد يشهد الزمن تحوّلات مفاجئة مثل التبدّل في الحالة النفسيّة للشخصيّة، أو ظهور ذكرى من الماضي، وهذا ما يؤثّر على إدراكها للزمن.
الحوار: “الحوار من أهمّ الوسائل المستخدَمة في رسم وبناء الشّخصيّة الروائيّة، فالشّخصيّة الروائيّة لا تُبنى من خلال أفعالها فقط، ولا من خلال أقوال الآخرين عنها فحسب، بل تُبنى، أيضًا من خلال ما تقول. حين تتحدّث الشّخصيّة مباشرة وتحاور جهرًا تكشف عن دواخلها وتُعَبِّر عن نفسها”. (عساقله، 2024. ص 109).
الحوار الداخليّ (المونولوج): يلجأ الراوي إلى الحوار الداخليّ؛ لأنّه حين تتحدّث الشّخصيّة مباشرة، وتحاور جهرًا تكشف عن دواخلها وتُعَبِّر عن نفسها، أما في الحوار الداخليّ فيكشفُ الكاتبُ عن مستوياتِ التأمّل والتّفكير والوعيِ، وهو أسلوب تيّار الوعي، الّذي فيه تداعيات التّفكير والتأمّل، أمثلة:
الراوي يتأمّل: “كيف بوسع الذّاكرة أن تحتمل هول المجزرة دون أن تنفجر؟ كيف خزَّنت في ثناياها كلّ ذلك الألم والموت، ثم عادت بعد ذلك لتنبض من جديد؟” (ص 10).
الراوي يتساءل: “ما الّذي جرى بالضَّبط؟ أين أنا؟ وما الّذي يحدث؟ ومن هؤلاء؟” (ص63).
الراوي يتساءل: “تُرى هل بوسع البشر إعادة الزمَّن إلى الخلف؟ ولو عاد الزَّمن إلى السَّابع أو الثامن من نيسان عام 1948 هل سيصبح بوسعنا آنذاك أن نتجنَّب المجزرة؟ (ص 131).
الحوار الخارجيّ: محادثة بين شخصين أو أكثر، فيه تواصلٌ معَ الشّخصيّات الأخرى. تعتمد الشّخصيّة عليه للحصول على أمر ما من الآخرين، أو الاستفسار أو التعرّف على الآخرين أو تقديم أنفسنا لهم أو طرح قضيّة للآخرين وفي الأساس، هو وسيلة التّفاعل بين الناس، يساعد الحوار الخارجيّ في العمل الأدبيّ المتلقّي على فهم أحداث القصّة وحبكتها والصّراعات المختلفة بين الشّخصيّات، أمثلة:
حوار بين الخال ياسين وبين بهجت أبو غربية: “أريد سلاحًا … قال خالي.
أجابه: لن تحتاج أكثر من مسدّس، قال له، وأضاف: غدًا تعال في مثل هذه السَّاعة سأعطيك مسدَّسًا” (ص53) وحوارات منتشرة على طول الرواية.
ثنائيّات ضديّة: الثنائيّة الضديّة تعني تواجد أمرين أو قضيّتين معًا، غالبًا ما يكونان متعاكسَين، مثل: النور والظلام، الخير والشر، الذكر والأنثى. الثنائيّون هم الّذين يقولون بأصلين للوجود مختلفَيْن تمام الاختلاف، لكلِّ منهما وجود مستقلّ في ذاته، وبدون هذين الأصلين لا يمكن فهم طبيعة الكون، الّذي تتصارع فيه القوى المتضاربة، الّتي ينتمي بعضها إلى أحد المبدأين، وينتمي البعض الآخر إلى المبدأ الآخر، ممّا يعني أنّ حقيقة الوجود تنطوي على انقسام داخليّ وتقابل ضروريّ دائم بين أصلين، لكلٍّ منهما قوانينه وأطواره الزمنية الخاصّة به، وأوّل من صاغ المصطلح حديثًا، هو المستشرق البريطانيّ “توماس هايد” (حسب الويكيبيديا).
رواية “يس” مليئة بالثنائيّات الضديّة، فالبئر الّتي كانت تغذي القرية بالماء، هي ذاتها الّتي تحوَّلت إلى قبر أثناء حدوث المجزرة، والمسجد الّذي كان ملاذ المصلّين إلى الله وأمانهم تناثرت دماء جدّ الراوي هناك عندما اقتحمته مجموعة “يهودا سيفل” وأطلقوا النار عليه.
وأقام الاحتلال مشفى للمجانين فوق أَشلاء القرية الممزَّقة: “اليس من الجنون أن يقام مشفى للمجانين على أرض دير ياسين؟ (ص 182)، “كيف يمكن بناء دولة على جبل من العظام” (ص 188)، “وجعلوا من قبر ياسمين قبر القديسة (ايدين) ابنة يهودا لتكون محجًّا لهم من جهة” (ص 196)، “كيف يتصالح الدَّم مع الرصاص وينسى”(ص 213).
الثنائيّة الضديّة موجودة بكثرة في الإبداع الأدبيّ، خاصّة الشعر منه، والّذي يحتوي في جوهره على عوامل التضادّ ممّا يؤدّي إلى المفاجأة والتوتّر، والعودة إلى التأمّل بحثًا عن ماهية الأمور، والسؤال الّذي يتبادر إلى أذهاننا، أحيانًا: كيف علينا التعامل معه؟
خلاصة
قمنا في هذه الدّراسة بمحاولة الوصول إلى حكاية مجزرة دير ياسين، فوجدنا أن الرّواية غنيّةً بالتّفاصيل التاريخيّة وأوصلتنا في نهايتها إلى مخيم الزرقاء في الأردن، وأيضًا إلى مذابح صبرا وشتيلا. والراوي يسرد الحكاية كمُشاهد بضمير المتكلِّم على الرغم من أن مشاهدته كانت ممّا سمعه وممّا تأمّله بحواره الداخليّ، فشعرنا أنّه كان حقًّا هناك. توصّلنا إلى أنّها رواية ذاكرة. هي رواية مثيرة يسترجع فيها الرّاوي المعلومات كأنّها ذكرياتُه بالتّفصيل. لغتها سهلة للمتلقّي فتجذبه للاستمرار في قراءتها خاصّةً في استخدامه التّعابير اليوميّة السّائدة ممّا جعلها واقعيّةً تشعرُه بأنّه يشاهد الأحداث وكأنّه كان حاضرٌ ساعةَ حدوثها.
أحمد أبو سليم
شاعر وأديب أردنيّ من أصول فلسطينيّة، ولد في الزرقاء في الأردن. أنهى دراسة الثانويّة في الزرقاء سنة 1983. سافر إلى تركيا لإتمام دراسته الجامعيّة، ثم تركها مغادرًا إلى الاتحاد السوفيتيّ ليحصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكيّة من جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو عام 1992. أصدر خمسة عشر كتابًا في الشعر والقصّة والرواية. شارك في برنامج أمير الشعراء، وحصل على لقب شاعر القضيّة. له قصص قصيرة وقصائد ومقالات منشورة في الصحف الأردنيّة والعربيّة. شارك في عدد كبير من المهرجانات في العواصم العربيّة. عضو في رابطة الكتّاب الأردنيّين، والاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، واتحاد كتّاب الإنترنت العرب. ترجمت بعض قصائده إلى اللّغة الإنجليزيّة، وصدرت في كتاب سلسلة شعراء عرب معاصرين، ونشرت بعض القصائد في المجلّة الأمريكيّة (الحياة والأساطير)، وعلى مواقع إلكترونيّة أخرى. تُوِّجت رواية أحمد أبو سليم “يس” بجائزة أفضل عمل أدبيّ عن مدينة القدس المحتلة لعام 2022، والّتي يمحنها ملتقى المثقفين المقدسي والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيّين.
المصادر
أبو سليم، أحمد. (2021). يس. رواية. الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيّين. رام الله.
الدلو هدى. (2022). “يس”، رواية فلسفيّة تستنهض وعي الضحية كعائق أمام التحرير. موقع فلسطين أون لاين، (16 مايو 2022). https://felesteen.news/p/108398
أُوخماني، عزرييل. (1979). معجم المصطلحات الأدبيّة (أ). سفريات بوعاليم. تل-أبيب.
بحراوي، حسن. (2016). بِنية الشكل الروائيّ. المركز الثقافيّ العربيّ. بيروت.
حج محمد، فراس. (2024). ذات مكان ذات أنثى: دائريّة السرد لقصّة عاطفيّة. 8.2.2024 موقع منكم. https://mincom.co.il/
عساقله، عصام وخديجة مرعي. (2024). بناء الشّخصيّات في روايات أيمن العتوم. دار يزن للنشر والتوزيع، دالية الكرمل.
مصطفى، جمال. (2022). في تجربة الغياب | قراءة في فلسفة هايدغر. 28.11.2022. موقع فسحة. https://www.arab48.com/%D9%81%D8%B3%D8%AD%D8%A9/%
مجدي وهبة وكامل المهندس. (1984). معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان ناشرون. بيروت.
موقع المصري اليوم. (14.11.2024). حكم قراءة سورة يس لقضاء الحاجات. https://www.almasryalyoum.com/news/details/3306680
موقع الطبي. (22.12.2013). متلازمة | Syndrome
https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7
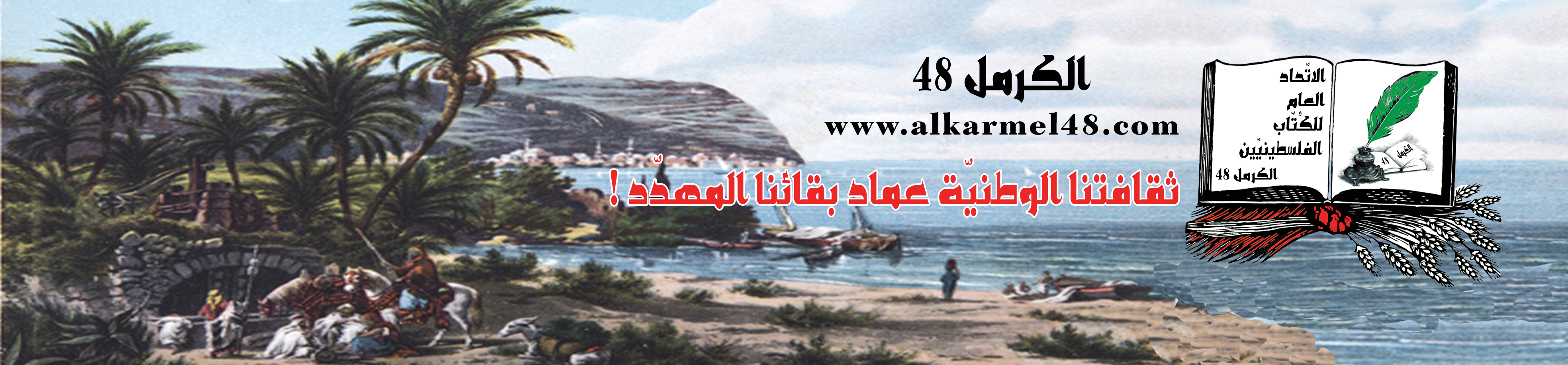 Alkarmel 48 الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48
Alkarmel 48 الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48