بمناسبة الأول من أيار، كل أيار وأنتم وعمال العالم وشعبنا بألف خير، وفي ذكرى النكبة، كل عام والعودة أقرب، في زمن يسيطر فيه الشّر على العالم، ولكن فجر الحرية، لا شك، قريب لكل المظلومين في العالم.
تُشكّل رواية فتى أم الطوابين للكاتب حسين أمين كنانة تجرُبة أدبية فريدة، تمزج بين السَّرد الفني والتَّوثيق الشَّعبي، إذ يتعامل الكاتب مع الذَّاكرة الجمعية ككائن حي مهدَّد بالاندثار، مستعينًا بتقنيَّات السَّرد الشفوي ليعيد بناء ماض لم يوثِّقه التَّاريخ الرَّسمي. فيتَّخذ السَّرد في الرواية طابعًا حكائيًا متفرعًا، حيث لا تسير الحكاية بخط مستقيم، بل تتشظَّى عبر ذكريات الأجداد والامهات والمرويّات المتوارثة في البيوت والحارات القديمة، ومن خلالها يستعمل الكاتب تفاصيل حسّية دقيقة، تعبّر عن طبيعة الحياة اليومية في القرية، وكأنَّه يريد أن يخلق عالمًا نابضًا بالحنين والصّدق والعفويّة مستعينًا بالأمثال والأغاني والشّعر والاقتباسات التراثية في العديد من المواقف.
رواية فتى ام الطوابين ، تعد محاولة جادَّة لاستعادة ذكريات مهددة بالاندثار، والكاتب يستعمل أسلوبًا تأمليًا عميقًا، في شتى المواضيع التي يتطرَّق اليها في الرواية، مستعينًا بالكثير من الاقتباسات من مختلف المصادر الأدبية والفلسفية العميقة بلغة عربية عالية وأسلوب سلس مما يدل على ثقافة عالية ووعي عميق جدًا عند كاتبنا، واضعًا أمامه هدف استعادة صورة الماضي الممزَّقة والمتشظّية. كما يُظهر النَّص في الرّواية، وعيًا نقديًا بالذَّاكرة والتاريخ ويعكس رغبة الكاتب في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من زمن لم يشهده لكنَّه يشعر بالانتماء العميق إليه. ومن هنا نستطيع أن نجزم أنَّ رواية فتى أم الطَّوابين، ليست رواية عادية، بل هي تأمُّلات عميقة في الذّاكرة والهوية، وتغوص في عالم التربية وأساليبها القمعية المتبعة في ذلك الزمان، وتقدّم لنا بلغة جميلة سلسة تخاطب العقل والفكر قبل العاطفة.
الشّظايا الصَّغيرة من القصص والحكايات الاجتماعية والتاريخية، الَّتي تداولها الناس البسطاء في حياتهم اليوميَّة، وجعلوا منها حكايات وأساطير منقولة من الإباء إلى الأبناء، هي الَّتي أهملها التَّاريخ أو ترفَّع عن ذكرها ناسيًا أو متناسيًا وجودها وأثرها في حياة المجتمع، من منطلق أنَّ التَّاريخ يكتبه المنتصر، فلا يلتفت إلى عذابات الفقراء والمظلومين.
أبرَزَها التَّاريخ الشفوي بشتى الوسائل الاجتماعية المتاحة من الحكاية أو الممارسة اليومية أو القصَّة الشَّعبية، وصولًا إلى الرّواية الَّتي تحاول الولوج إلى تفاصيل الاحداث وروايتها بطريقة قصصيّة استعراضيَّة، تتعمَّق في تفاصيل الحياة اليوميّة للمجتمع وتدخل في تفاصيل الأحداث المنسيَّة، تزيد عليها أو تزيل عنها ما علق بها من شوائب، لتعرض أمامنا صورة حقيقية متكاملة غير مشوهة للتاريخ، صورة عميقة حقيقية، تساعدنا على فهم واقعنا الاجتماعي والسياسي والتاريخي وتطوّره بتفاصيله الدَّقيقة، أو تساعدنا على تجنب سلبياته وتطوير إيجابياته، وتعيدنا وجدانيًا وعاطفيًا إلى تلك الحقبة لنعيش تفاصيلها.
يفتتح الكاتب روايته بمقدِّمة تحت عنوان” ما لا بد منه”، يقدم فيها هدفه ورؤيته الخاصّة لروايته، وكأنَّه يريح القارئ من عناء التَّفكير بأهداف روايته فيقول ص 5 “لقد أبى قلمي إلَّا أن ينفث ما ينفث -هنا – ليزيح ثقلًا ناء به صدري، ثقلٌ سأخطّه كشظايا صور متناثرة لملمتها إمَّا من أفواه رجال ونساء عايشوا ذلك الرَّجل الَّذي كبرنا على أخباره، وذاعت في البلدة شهرته، حتى زاحم بمنكبيه أبطال جبل “اوليمبوس” في عيوننا نحن الصِّغار من أبناء إخوانه وأقاربه، وإمّا من أفواه أترابنا الَّذين ما زالت في أذهانهم بقايا بعضُ صورٍ له يخاف الواحد فينا أن تندرس مع ازدلاف الدَّهر”، فنحن أمام رواية تاريخية عن رجل فريد لم يذكره التاريخ أو لم ينصفه حقه بعد، او حقبة تاريخية منسيّة، يريد الكاتب وبشغف أن يروي لنا سيرته وتاريخه ومعه تاريخ حقبته وأسلوب حياته.
عن عشقه وحبه لجمع التَّاريخ المحكي والمكتوب يقول حسين في ص 7 ” أُحبُّ القديم وأعشق الأرشفة، أحافظ على الماضي القريب كما لو كان تراثًا كنعانيًا أو ثموديًا. إنَّ العثور على نص تائه بين ثنايا الكتب يرتبط بماضينا يجعل يومي ورديًا للغاية، أسطّر بين الفينة والأخرى أحداثًا آنيَّة، وربما أعلِّق عليها، علَّها تُصبح ارشيفًا لأبنائنا من بعدنا” وهذا تأكيد آخر من الكاتب أنَّ الهدف الأساسي من روايته، لملمة شظايا تاريخنا المشتَّت بفعل النَّكبة ألَّتي حلَّت بشعبنا، فنكبت تاريخنا كما نكبت شعبنا، وليصبح الهدف لملمة هذا التشتت وبقايا الاخبار، لإظهار الصّورة الحقيقيَّة لشعبنا في حياته الاجتماعية والسياسية اليوميّة وقد أبدع الكاتب في وصف المشهد.
عن التاريخ الشفوي وأهميَّته ودوره في رسم ملامح التَّاريخ أو تصحيحه تقول الباحثة روضة غنايم في كتابها ” حيفا في الذَّاكرة الشفوية” ص 28 ” التَّفصيلات الصَّغيرة والكبيرة التي يمدنا بها الساردون تساعدنا على قراءة المُستتر، وكشف المُغيَّب من التَّاريخ. وهذه السرديات تورَّث من الأجداد إلى الأبناء والبنات، ثمَّ إلى الاحفاد والحفيدات وإلى مَن بعدهم. إذ لم تُرو هذه السَّرديات، فستنسى وتغيب عن المشهد التاريخي.
لم يترك حسين كنانه للقارئ مجالًا للتَّفكير في عتبة النَّص الأولى فخصَّص له ما يشبه المقدّمة، فراح يشرح عن مغزى كل كلمة فيه دون أن يترك للقارئ شيئًا للتَّفكير، وليته اعتمد على ذكاء قارئه وسرعة بديهته في اكتشاف مدلول العنوان، فالعنوان برمزيَّته يعتبر أحيانًا خلاصة ما يرمي إليه الكاتب، واكتشاف مراميه هي متعة القارئ وليست وظيفة الكاتب، فليته لم يفعل، وقد يكون محقًا او معذورًا في ما فعل، امَّا وقد فعل فلنتتبَّع خطوط قلمه في رسم معالم التَّاريخ الشفوي، من خلال ستة شظايا روايته الجميلة، ولنكتشف بعض الدّر الكامن في ثناياها.
تقول الباحثة روضة غانم في نفس الصدر، ص 27 “يعتمد التَّاريخ الشفوي على سرديات أفراد الشَّعب وذكرياتهم ومذكراتهم وخبراتهم عن تاريخهم وتاريخ بلدهم ودولتهم، والمنعطفات والتَّحولات الكبرى التي يمرون بها. من خلال السرديات الشفوية الفرديَّة الذَّاتية نستطيع أن نفهم حياة النَّاس وتجاربهم وتاريخهم في الماضي والحاضر وأن نتعلَّم عنها”.يعي كاتبنا صعوبة ومشاق ما هو ذاهب إليه من بحث في دفاتر التاريخ، ويعرف أن ليس بإمكان أيِّ أحد إذا لم يكن عنده موهبة البحث وإمكانياته، وهو يعبّر بذلك عن مخاوفه، ولكنَّه يقدِم على محاولة فريدة وممتعه وقد أجاد في خوض التَّفاصيل المحكية ورسم معالم روايته الشيقة.
يقسّم الكاتب روايته الى ستَّة شظايا، والشظية في اللغة مصطلح دلَّ على جسم غريب حاد، قد يكون من الخشب أو الزجاج أو المعدن، ويكون جزء من شيء أكبر نتيجة تناثره حيث تعتبر فلقة تتناثر من جسم صلب. وهذا يفيد أنَّه بصدد الدخول إلى عالم مجتمع فلاحي مغلق ومتماسك، من الصَّعب تفكيك جزيئاته والتَّعبير عن مكنوناته بكل وضوح وشفافية، ولكنه يفعل ذلك من أجل الحقيقة ومن أجل إيضاح الصّورة.
في الشظية الأولى، يرسم لنا معالم المكان وطبيعة القرية العربية الفلاحيّة المشهورة بأمِّ الطوابين، بل ويرسم صورة بطل روايته الطفوليَّة “يوسف علي الحسن”، بتفاصيلها الدّقيقة وكأنَّه يقول، انَّه خُلق بطلًا بعقله وبنيته وتربيته، رغم ما يشوبها من عنف في التربية وصعوبة في الحياة الَّتي يجترحها البطل من قلب المعاناة والفقر، والأوضاع السياسيّة الَّتي يصفها بأدق التَّفاصيل، ويصل إلى أساليب التربية العفوية من الضَّرب والعُنف، إلى الاحترام والتَّقدير وإلى المحبة والاخوَّة ألتي كانت تسود أو كانت تطغى على ما عداها في الحياة اليومية. فالبيت يتكون من غرفتين فقط ويشاركهما فيه بقرته وعجْلُها وحصانه “الكديش” الكسول، وعن التربية يقول الكاتب” ص – 22 – 21″ لم يكونوا في في هذه الازمان يقرأون أبحاثًا في تربية الأبناء ولا يبحثون في الانترنت أو في جوجل عن أفضل الوسائل للتَّعامل مع مشاكسة هذا الولد، كان أولاده وبناته التّسعة يستهلكونه وتكاد أمورهم تبتلعه، وكذا بقره وحصانه وأراضيه التي تنتظر من يحرثها ويهتم بزيتونها تزبيلًا وقطفًا، كان يستعين بأبنائه الكبار حسن ومعين في حراثة أراضيه في حي الصَّبرة وزراعتها البندورة، لتبيعها “مسعدة أبو الفريحات” في سوق النَّاصرة بعد مناوشات مع الشارين، تلك الأراضي الَّتي خسرها بعد أن باعها لينزل أخاه مصطفى الحسن من على حبل المشنقة قبل أيام معدودة من التنفيذ.” انه يرسم مشهدًا كاملًا متكاملًا لحياة الفلَّاح في فترة عصيبة من حياة شعبنا الفلسطيني، زمن الحكم العسكري الإنجليزي وما تلاها بعد النَّكبة، حتى أنَّه يعود بالذاكرة إلى عهد ظاهر العمر والظلم الذي ذاقه المواطن في تلك الفترة كما في حادثة” لبش البطيخ” الذي قيَّد فيه أحد الخدم ليعود من مسافة طويلة دون أن يجرؤ على فكه، فكانت علامة من علامات نهاية حكمه. ويصل إلى حكم الأتراك والسفر برلك الذي لم يذكره، ولكنَّه تحدث عن أكل “الكردوش” المصنوع من حبَّات القمح والشعير المستخرج من روث الابقار يقول ص 36 “فيغسل روثها كما تغسل الملابس، ليستخرج أخيرًا بعيض حبَّات قمح أو شعير أو ما يؤكل… بعيض حبَّات لم تقم معدتها بهضمها رحمة بهؤلاء الجياع، كان السَّابق يأخذ تلك الحبيبات مسرعًا إلى أمّه لتصنع منها خبزًا يسمى بالكردوش. ولينقلنا الكاتب بعدها مباشرة للاحتفال بعيد استقلال بلادي قلبي فرحان. إذن هو في صفحات قليلة من روايته يستعرض تاريخًا فلسطينيًا مليئًا بالحروب والنكبات من الاتراك إلى الانجليز وحتى إلى إسرائيل، ومن خلال الاستعراض الجميل يطلعنا على أساليب التربية، في البيت وفي المدرسة وحتى قوانين الشارع، وقوانين المجتمع الصّارمة التي مارسها الأب وطبَّقها على أبنائه كسلطة عليا في تربية وتنشئة الأبناء، يتخلَّلها العلاقات الاجتماعية القويّة والمتماسكة بين أفراد المجتمع أيا كان انتماؤهم الطائفي أو الحمائلي أو غيره.
وفي الشظية الثانية يتمحور الكاتب في صراع الأجيال على أهمية العلم والتعلم والنقاش المستفيض بين الماضي والحاضر بين الجيل الشاب الذي وجد نفسه وجهًا لوجه أمام مجتمع فلسطيني منهار اقتصاديًا محاصر سياسيًا واقتصاديًا والجيل الذي عاش النكبة وما تلاها وصولا إلى فترة الحكم العسكري الإسرائيلي حيث لا يستطيع الانسان أن يعتاش على الزّراعة لوحدها بعد أن صودرت أرضه وقلّت موارد الرزق فاضطّر إلى البحث عن عمل عند الخواجات أي الخروج من القرية إلى المدينة أي التحول من اقتصاد الاكتفاء الذاتي عند الفلاح الى التبعية الاقتصادية والارطباط الكلي بعجلة الاقتصاد العام، وفي حالتنا إبن يافا يذهب إلى حيفا كي يحصل على لقمة العيش، يستلّها من فم مصادري أرضه. يقول الكاتب على لسان حسن الأخ البكر ليوسف العلي ص 60″ يا أبي! زمننا غير زمنكم، لن نستطيع أن نعيش مما تبقّى من الأرض الحاكم العسكري يخنقنا، ويحصي أنفاسنا، ويعد خطواتنا، تذهب يمينًا بتصريح وشمالًا بتصريح، فإن زدت على المدَّة التي قرّرها لك، منعت لأشهر من العمل خارج البلد، وقد تسجن إن أصررت على التّسلل”. وبعدها يخوض في شجاعة يوسف وحتى إخوته في تحدي الحاكم العسكري والمحكمة للعمل ولكي يستلوا لقمة العيش من سلطان جائر. ويصف الكاتب هذه الشجاعة والبطولة التي تحلّوا بها وموقفهم أمام الظلم وبعد النكبة ليقول وهي من أجمل ما قاله الكاتب ص 76″ الويل كل الويل لمن تسوّل له نفسه أن يكون ضعيفًا فقيرًا عائلًا، لقد ارتفعت رحمة العباد بعضهم لبعض، ولم يبق لهم إلا أن يعتمدوا على سواعدهم، هذا ما تعلّموه من آبائهم، غلطة الآباء في التواكل كلَّفتهم وطنًا، ولن يسمحوا بأن يلدغوا من ذلك الجحر مرَّة أخرى”.
ويذهب بنا الكاتب إلى لب الرِّواية، وشخصيتها المركزية يوسف علي الحسن، ليسرد لنا في الشظية الثالثة والرابع والخامسة والسادسة، تسلسل الاحداث في شخصية البطل ،الإشكالية في نظري، شخصية براغماتية من الصعب على القارئ الانسجام والتعاطف معها كليًا أو الوقوف ضدها ورفضها بشكل سافر، شخصية نستطيع أن نقول عنها أنَّها صنعتها الظروف ووضعتها في مسار الحياة القرويَّة والتربية العفوية في تلك الفترة، وصقل هذه الشخصية من ممارسات الحياة القروية القاسية، وليحدّثنا عن تجربة السّجن وعنف السجان والمواقف البطولية والوطنية لهذه الشخصية رغم اهتمامها أو انخراطها في عالم الاجرام، لتنهي مسيرتها بحادث سيارة مع خنزير وسط الطريق، ليتلوها مصرع طفلته مريم بعضة كلب مفترس، وهي مفارقات الحياة وربما ظلمها.
أخيرا، كانت كلماته الأخيرة ص 310″ من أراد ان يبكي فليخرج وليبك على نفسه لا عليّ، أنا يوسف العلي أتذكرون؟ عشت قويا وسأموت كذلك.” تعد رواية فتى أم الطَّوابين، محاولة واعية للحفاظ على الذَّاكرة الشفويَّة الفلسطينية من خلال الفن الروائي متجاوزة حدود الحنين لتصبح شهادة على زمن يتلاشى، وحافزًا على التَّفكير في دور الحكاية كأداة ثقافيّة مقاومة للنسيان. مبارك للكاتب هذا الإنجاز، وننتظر المزيد.
المداخلة التي ألقيت في حفل توقيع رواية “فتى أم الطوابين” للأديب حسين أمين كنانة
يوم 2.5.2025 في المركز الثقافي يافة الناصرة
تقع الرواية في 316 صفحة من الحجم المتوسط،
الطبعة الثانية، اصدار مكتبة كل شيء الحيفاوية عام 2025
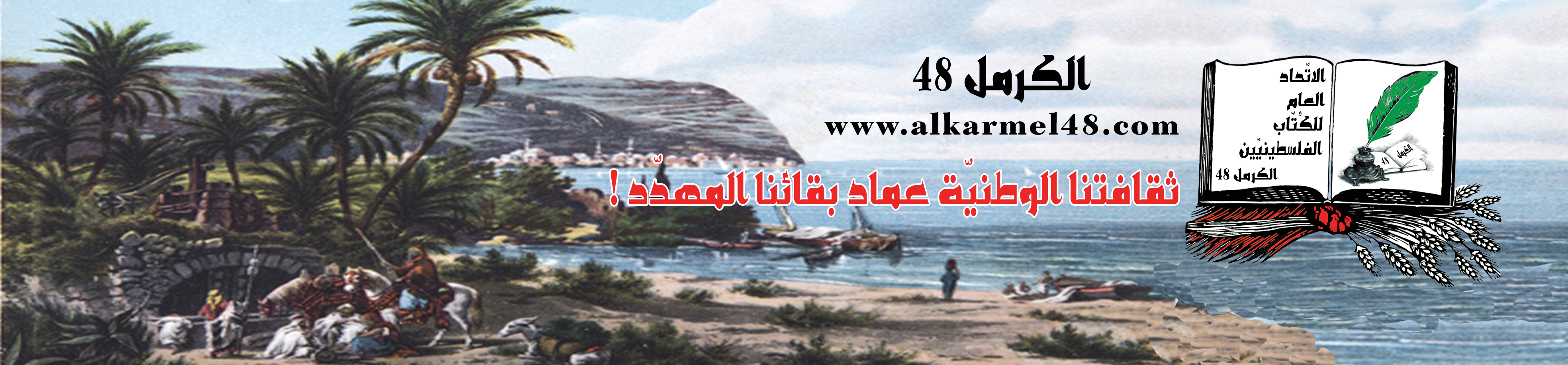 Alkarmel 48 الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48
Alkarmel 48 الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48