مدخل
سنقوم في هذه الدراسة بعرض البِنيّة الروائيّة، والمضمون القصصيّ، ونحاول فهم العلاقة بينهما، ثم نفحص ما هو الدور الروائيّ الذي تلعبه المرجعيّات التي تتّكئ عليها السرديّة، ونفحص أسلوب السرد متسائلين:
هل هو تيار الوعي؟
هل هو استرجاع الذكريات؟
هل سرديّة الرواية خليط من استرجاع الذكريات عن وعي وإدراك؟
البِنية الروائيّة
رواية “منزل الذكريات” هي رواية قصيرة، نوڨيلا، تتكون من خمسة فصول ولكل فصل مرجعيّة روائيّة، بمثابة شعار ((Moto رئيسيّ، وعناوين فرعيّة تخدم الفصول الخمسة، وكلّها معًا بمثابة مِسْبَحة، تُشَكِّل مبنى الرواية كاملة، تجتمع معًا، وترتبط بعقدة المسبحة “الشاهد” بعنوانها الأساسيّ “منزل الذكريات”.
مرجعيّات الفصول هي:
الفصلان الأول والثالث:
رواية “الجميلات النائمات”- ياسوناري كاواباتا)
رواية “ذكريات عن عاهراتي الحزينات”-غارثيا ماركيز
الفصل الثاني: كتاب النساء لابن قتيبة
الفصل الرابع: كتاب أخبار النساء لابن قيم الجوزيّة.
الفصل الخامس: رواية “الجميلات النائمات”-ياسوناري كاواباتا).
ما هي قصة “منزل الذكريّات؟
محمّد الأصغر في العقد التاسع من عمره، هو الشّخصيّة الرئيسيّة في الرواية، يعيش وحيدًا بعد أن فقد زوجته سناء التي ماتت بعد أن أصابها كوفيد 19، يشعر بالوحدة وطيفها يرافقه في كل حدث يجري له في نهاره، وفي ليله، وفي يقظته، وفي منامه، وفي كلّ مكان. وهنا يطرح الكاتب بشكل مفاجئ حنين محمّد الأصغر رغم العجز، في عمر الشيخوخة إلى ممارسة الجنس، وشعور قريبه رهوان بحاجة محمّد الأصغر، واصطحابه إلى بيت فريال في مستوطنه يهوديّة، والتي تديره كنزل للدعارة، وهذه تقدّم له سميرة فتاة جميلة وصغيرة في عمر العشرين، وترشدها قائلة: “اذهبي يا أمّورة إلى السرير، واخلعي فستانك ونامي”. ناولها حبّة دواء من جيبه، أخذتها وابتلعتها في الحال، ثمَّ انسلَّت إلى غرفة النوم… خلع ملابسه في تهيّب وحياء، واضطجع إلى جوارها… يتأمّلها… وبعد حين فاجأته قائلة بفتور: “ما نمت ولا دقيقةً واحدة. أكيد حبّة المنوِّم مغشوشة. ولازم تنتبه في المرّة القادمة”. ومرّة أخرى يخوض محمّد الأصغر تجربة العلاقة مع النساء، وهذه المرّة مع أسمهان، جامعة التبرعّات والعاملة المساعدة في بيته، والتي أرغمه أخوها جميحان بعد التهديد والوعيد على الزواج منها؛ ليسيطر على حياتهما، مما أدّى إلى خلعه في أعقاب ضغوط أخيها جميحان عليها، والاستيلاء على منزله، وقطعة الأرض التي ورثها عن أبيه. وهكذا خسر محمّد الأصغر كلَّ ما لديه.
المرجعيّات الروائيّة:
رواية “الجميلات النائمات”-ياسوناري كاواباتا
الرواية مكوّنة من خمسة فصول قصيرة مع العجوز إيجوشي الذي يذهب إلى منزل الجميلات النائمات، حيث يُتاح للعجائز تحقيق رغباتهم، في قضاء ليلة إلى جانب مراهقة نائمة تحت تأثير مخدّر، عجائز لا يجلبون المتاعب كما أطلقت عليهم مديرة المنزل، يقضون الليل في استعادة وهم شباب منقض.
إيجوشي الذي يدخل إلي المنزل للمرّة الأولى بدافع الفضول، تدفعه التجربة لتكرارها، خمس ليال في منزل الجميلات النائمات، يستعيد فيها ذكرياته، ينتقل عبر رائحة، أو لون، إلى ذكريات قديمة عن أمّه، عن ابنته، ونساء مررن في حياته، لقطات قصيرة سريعة كأنفاس الجميلات النائمات إلى جواره، يغوص كاواباتا من خلالها إلى أعمق مناطق النفس البشريّة، وواحدة من أكثرها تعقيدًا، يأخذنا إلى تلك المنطقة الغائمة بين الموت والشباب، والجنس والحب، دون كثير من التفاصيل أو الأحداث، فقط انتقال سلس بين مشاهد الذاكرة والمشاعر الدقيقة التي تثيرها في النفس، كاواباتا يواجهنا بتلك المخاوف الخفيّة، الخوف من العجز، من الفقد، ومن النهايات غير المتوقّعة أبدا.
خمس ليال يقضيها إيجوشي العجوز وحيدًا في مواجهة أسئلة النهاية، بينما ترقد إلى جواره جميلة نائمة، كشاهد على الخوف والوحدة التي لا مهرب منها، خمس ليال تنتهي بموت مفاجئ للجميلة السمراء النائمة بجواره، الجميلة الفتيّة، ذات الأنفاس الثقيلة، الجميلة السمراء التي تبدو وكأنها غير يابانيّة كما وصفها، الجميلة الغريبة المفاجئة. تمامًا كالموت.
هل ثمّة علاقة بين الرواية وبين باليه تشايكوڨسكي؟ (أنظر ملاحظة 1 في الهوامش)
هي علاقة تلميح Allusion (أنظر ملاحظة 2 في الهوامش) لباليه تشايكوڨسكي وهي تلميح لرغبات الراوي.
رواية “ذكريات عن عاهراتي الحزينات”-غابرييل غارثيا ماركيز.
في الرواية يقوم صحفيّ عجوز بالاحتفال لتوّه بعيد ميلاده التسعين، ثم فجأة تخطر في باله فكرة غريبة جدّا، وهي مُمارسة الجنس مع عاهرة شابّة. يقوم من مكانه ثم يتوجّه بحثا عنها، وفعلا يعثر على شابّة جميلة ممشوطة القوام، والهندام، تقترح عليه ممارسة الجنس معه، أو بالأحرى بيع عذريتها له من أجل المال؛ قصد مُساعدة عائلتها الفقيرة. عندما ينوي ممارسة الحب معها يكتشف أنه مُعجب بها، وأنه “يحبّها”، خاصة أنه لم يسبق له أن جرّب طُعم الحبّ ومذاقه.
عندما يزور محمد الاصغر في الحلم بطلا روايتي “الجميلات النائمات” و”ذكريات عن عاهراتي الحزينات”، ويتذكّر ما ألمّ ببلادهما في الماضي، يتمنّى لهما أن يعيشا مع من يحبّان، ما تبقّى لهما من عمرهما بهدوء. وفي الحقيقة هذا ما يتمنّاه لنفسه، فهو واقع تحت الاحتلال فحاضره شبيه بماضيهم.
كتاب النساء لابن قتيبة
هو الكتاب العاشر والأخير في موسوعة عيون الأخبار لابن قتيبة، وفيه تكلّم عن أخلاق النساء، وما يُختار منهنّ، وما يُكره، وذوي الكفاية من الرجال، والحضِّ على النكاح، وذمِّ التبتّل، والحسن، والجمال، والقبح، والدمامة، والطول، والقصر، ثم تلاها بذكر المهور، وأوقات النكاح، وخُطَبه، ووصايا الأولياء للنساء، وسياسة النساء ومعاشرتهنّ.
كتاب “أخبار النساء” لابن قيم الجوزيّة.
يتناول الكتاب موضوعات عديدة، مثل: باب ما جاء في وصف النساء، وفي جمالهن، وباب يذكر فيه من صيّره العشق إلى الأخلاط والجّنون (يروي فيه مفاعيل الحبّ عندما يتحوّل الى جنون أو يختلط به)، وباب ما جاء في الغيرة، وباب ما جاء في وفاء النساء، وباب ما جاء في غدر النساء، وباب ما جاء في الزنا والتحذير من عواقبه، وباب ما جاء فيما لا يحاط به، وباب ما جاء في خلق النساء، ويتميّز الكتاب بأسلوبه الطريف ولغته القويّة.
هذه المرجعيّات الأربع تشكل تناصًّا مع حالات الراوي المختلفة في القصّة، ما يعني حالات الراوي تتقابل مع الحالات في القصص المرجعيّة (التناصّ. انظر ملاحظة 3 في الهوامش).
علاقة “منزل الذكريات” مع المرجعيّات
العنوان “منزل الذكريات” هو عتبة الرواية منه ندخل إلى عالم المتن.
منزل: المنزل في المفهوم العامّ، يتألّف من مكان مُعَدّ ليؤمّن حماية العائلة من الأخطار الجويّة (رياح، عواصف، حر، برد) ومن هجوم الحيوانات في القرى والغابات، أو حتّى من هجوم المجرمين واللصوص في المدن الحديثة. وكانت الغاية من بناء المنزل، هي طلب الأمان سواء من أخطار بيئيّة، أو حيويّة. لذا فهو مثال أساسيّ للسكن والمأوى.
الذكريات ناتجة عن قدرة الإنسان على تذكّر، واستحضار أحداث، وحالات من الماضي، فقدرته على التذكّر أفادته من خبرات الماضي، وساعدته في تكوين حاضره، وبناء مستقبله، ولتحقيق هذا هو بحاجة إلى القدرة على التَخَيُّل التي تفيده في اختيار أهدافه، وتخيّل احتمالات تحقيقها. هنا برز الدور الروائيّ لـلمرجعيّات، وهو التعرّف إلى تجربة الشيخوخة عن طريق التناصّ بين محمّد الأصغر الفلسطيني في “منزل الذكريات”، وبين العجوزين في روايتي كاواباتا الياياني، وماركيز الكولومبي، في حالة مشتركة في المضمون على ضوء كتاب النساء لابن قتيبة، وكتاب “أخبار النساء” لابن قيّم الجوزيّة، عن طريق المقارنة لمعرفة أوجه الشّبه والاختلاف بين الثّقافات المختلفة.
ورد في أدلة MSD لمحة عامة عن الشيخوخة (انظر ملاحظة 5 في الهوامش).
كثيرًا ما يتساءل الناس عن الأشياء التي يشعرون بها مع تقدمّهم في العمر، هل هي طبيعيّة أم غير طبيعيّة. على الرغم من أنّ الناس يشيخون بشكل متفاوت نوعًا ما، إلا أنّ بعض التغيُّرات الناجمة عن العمليّات الحيويّة الداخليّة في الجسم، تكون ناجمة عن الشيخوخة في الحقيقة.
الشيخوخة هي التغيّرات الطبيعيّة المستمرة والتدريجيّة التي تطرأ على الجسد اعتبارًا من بدايات البلوغ. تبدأ العديد من وظائف الجسم بالتراجع في بدايات منتصف العمر. لا يوجد سنّ محدّد يمكن اعتباره سنّ الدخول في مرحلة الشيخوخة. ولكن، جرى التعارف على أنّ عمر 65 سنة، هو العمر الذي يشير إلى بداية سنّ الشيخوخة.
يمكن الإجابة عن سؤال “متى يدخل الشخص في سنّ الشيخوخة” بعدّة طرق:
العمر الزمنيّ: يعتمد على مرور الوقت وحسب. ويُعبِّر عن عمر الشخص بالسنوات.
العمر البيولوجيّ: يشير إلى التبدّلات الشائعة التي تحدث في الجسم مع زيادة العمر.
العمر النفسيّ: يعتمد على شعور الشخص بذاته، وطريقة تصرّفاته. على سبيل المثال، يمكن اعتبار شخص يبلغ من العمر 80 عامًا، أكثر شبابًا من الناحيّة النفسيّة، إذا كان يمارس عمله، ويخطّط لمهامه المختلفة، ويترقّب الأحداث المستقبليّة، وينخرط في نشاطات متنوّعة.
يمكن للتغيّرات في مستويات الهرمونات الجنسيّة عند الرجال، أن تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون، ممّا يؤدّي إلى الضعف الجنسيّ، وتراجع الرغبة بممارسة الجنس، إلّا أنّ هذا التراجع يكون تدريجيًا، وبأشكال مختلفة. وعلى الرغم من التراجع التدريجيّ في الجريان الدمويّ، إلّا أنّ معظم الرجال يحتفظون بالقدرة طيلة العمر. ولكن، قد لا تدوم لفترة طويلة كما هيَ الحال في فترة الشباب.
يعيش الراوي في “منزل الذكريات” تجربة يمرّ بها، تستدعي المرجعيّات الشبيهة بتجربته. يريد محمّد الأصغر أن يجرّب ما قرأه في المرجعيّات المذكورة، يريد أن يسير على خطى العجوزين في الروايتين.
كان العجوزان في الروايتين يذهبان إلى نزل عاهرات تديره امرأة، تستقبل فيه كبار السنّ الذين يريدون إمتاع شيخوختهم. فتقدّم لهم نساء للمتعة، شريطة ألّا يفعل الزبون العجوز شيئًا مع الفتاة المنوّمة. تنام الفتاة طيلة الليل، يستمتع الزبون العجوز بجمالها دون الاقتراب منها، وهكذا خاض محمّد الأصغر نفس التجربة، بمساعدة قريبه رهوان، الذي أخذه إلى بيت فريال التي تُقدِّمُ فيه خدمات للمسنّين، مستعينة بفتيات جميلات، كتلك التي تقدّم في رواية منزل الجميلات النائمات. يدخل محمّد الأصغر مع الشابّة الجميلة سميرة نفس التجربة التي مرَّ بها الراوي، بطل رواية الجميلات النائمات، وبطل رواية ” ذكريات عن عاهراتي الحزينات”، فيقول: “استحضرت عجوز كاواباتا فلم يتخلّف عن الحضور. وفي اللحظة التالية أطلّ عليّ من مكان ما في الغرفة عجوز ماركيز من دون أن أستدعيه. رأيته يحدّق في جسد سميرة بفضول، وشبق، كما لو أنّه محروم من متعة الأجساد منذ أمد طويل. أحسست باستمتاع وأنا مستلق بالقرب من جسدها، وقلت لنفسي: هكذا تكون التجارب الحسيّة وإلّا فلا. ولم يلبث العجوزان أن ابتعدا وغابا. قلت: أخذتهما الغيرة لأنّ جمال سميرة لا يضاهى”(ص.37).
يثير الانتباه موضوع الشيخوخة والخرف، ومخاوف الراوي منهما، وتبرز هذه المخاوف في افتتاحيّة الفصل الرابع (ص 123) من الرواية بعنوان، “خشية”:
” صرت من كثرة الضغوط عليَّ في خشيةٍ من وصولي إلى حالةٍ نفسيّةٍ وعقليّةٍ تجعلني خرِفًا، أو فاقدًا للتوازن، أو متورطًا في أفعالٍ شائنة نابعة من فقدان الإرادة، ومن عدم القدرة على التحكُّم في أفعالي وتصرُّفاتي”، ويحاول تبرير مخاوفه بطرح ما جرى لعجوز وزوجته من عائلة العبداللات، وبسوء العلاقة بينهما. خرف قريبه العجوز ظهر في تصرّفاته (ص 124): “يمكن حصرها في خروجه إلى الشارع، والوقوف على الرصيف، والشروع في التبوُّل على مرأىً من بنات الجيران، أو وقوفه قريبًا من نافذة بيته المطلّة على بيت الجيران، حيث يتعرّى، ويمعن في عرض مواضع من جسده على مرأى منهنّ، ما اضطرَّ الجيران إلى توجيه إنذارٍ لأبناء العجوز؛ لكي يضعوا حدًا لخرف أبيهم”. تبرز مخاوف الراوي في تساؤلاته: “هل يمكن أن أصل إلى حالةٍ شبيهة بذلك؟! أنا محمّد الأصغر بن منان العبداللات، أتمنّى أن يأخذني الموت قبل الوصول إلى ما يشبه تلك الحالة، أو أيّ حالةٍ من حالات البؤس والخراب. وأكاد أجزم بأنّني سأظلّ راجح العقل حتّى تحلّ لحظة الممات”(ص 124).
خشيته هذه نابعة من كونه فلسطينيًا، والواقع الفلسطينيّ جعله يهرب إلى عالم الذّكريات، من خلال تناصّ مع المرجعيّات الروائيّة (كاواباتا وماركيز)؛ ليبحث عن قضايا الشيخوخة عامّة.
الشعب الفلسطينيّ يعيش تحت الاحتلال، ويعاني من قساوته، ومن اعتداءات المستوطنين، ومن الفساد والعنف الداخليّ، المنتشر وبدون أي سلطة مانعة له. حتّى أنّ محمّد الأصغر لا يسلم من ملاحقة الجنود واعتقاله والتحقيق معه، ولذلك يوجّه انتقادات للتصرّفات الغريبة على المجتمع الفلسطينيّ، وكأنّه يقول إنّنا نعيش في زمن التفاهة، أو كما قال شولت (Ha Schult) بمناسبة اليوم العالميّ للبيئة: “نحن نعيش في زمن القمامة” (Age of Garbage) مستنكرا الانحطاط الأخلاقيّ.
محمّد الأصغر يرفض ويستاء من الواقع الحاليّ، فيقول: “أمّا أن يترتَّب على ذلك الحلم عقد قرانٍ وزواج، فتلك واحدة من مصائب هذا الزمان، الزمان الذي ابتُلينا فيه بطفيليّين زعران، وتجّار مخدّرات، وعملاء للاحتلال، يحملون السّلاح جهارًا نهارًا، يهدّدون به أبناء جلدتهم من المواطنين العزَّل، ورغم أنّهم قلّةٌ قليلة يعكّرون حياة الناس بممارساتهم السيّئة” (ص58).
و “أشعر معك يا أخي محمّد الأصغر، أنت تعرف أنّنا نعيش في غابة، وأنّ هذا الاحتلال أفسد حياتنا” (ص 59)، “هذا زمان السفلة والأوباش يا سناء” (ص 62) و “دفعني بقسوةٍ حتّى كدت أسقط على الأرض…… وعلى الفور أمر الجنود بوضع الكلبشات في يديّ …..”(ص 73). هكذا نجد في الرواية على امتدادها أوصافًا مختلفة على الواقع الفلسطينيّ الحاليّ الصعب.
أسلوب السرد في “منزل الذكريات”
هل هو تيار الوعي؟ هل هو استرجاع الذكريات؟
هل سرديّة الرواية خليط من استرجاع الذكريات عن وعي وإدراك؟
ما هو تيّار الوعي وما هو استرجاع الذكريات؟
يرى غنايم (1992، ص 15) أنّ تيّار الوعي هو نوع أدبيّ، يوظّف تكنيكيات عديدة لتصوير الحياة الداخليّة، التي تُحاكي الحركة الداخليّة للوعي بما يكشف دراميّة النفس التي لا تتوقّف، والحركة الموّارة التي تصطرع فيه”. هكذا يطمح غنايم في طرحه هذا إلى تأكيد الفكرة بأنّ تيار الوعي، يصبو إلى تحقيق الواقعيّة الذهنيّة، وأنّ استثمار المشاعر والأفكار جاء لتصوير مشاهد واقعيّة من داخل ذهن الشخصيّات ذاتها.
همفري (حسب سليمة خليل 2011، ص 182) يستخدم مصطلح تيار الوعي للدلالة على منهج في تقديم الجوانب الذهنيّة للشخصيّة في القصص، فهو يتغلغل في الشخصيّة بهدف سبر مكنوناتها الباطنيّة؛ ليقدم صورة لواقعها الداخليّ. ويرى أنّ مجال الحياة الذي يهتمّ به تيار الوعي، هو التجربة العقليّة والروحيّة، من جانبيها المتّصليْن بالماهيّة، والكيفيّة، وتشتمل الماهيّة على أنواع التجارب العقليّة من أحاسيس وذكريات، وتشتمل الكيفيّة على ألوان الرموز والمشاعر وعمليات التداعي”(همفري 1975. ص 22-33).
أمّا الذاكرة فهي إحدى قدرات الدماغ التي تُمكِّنه من تخزين المعلومات واسترجاعها. وتدرس الذاكرة في حقول علم النفس الإدراكيّ وعلم الأعصاب، وهي عمليّة الاحتفاظ بالمعلومات لمدة من الزمن لغرض التأثير على الأفعال المستقبلية. إذا كنّا لا نستطيع تذكّر الأحداث السابقة، لن نكون قادرين على أن نطوّر اللغة، العلاقات، أو الهويّة الشخصيّة. وتقوم الذاكرة قصيرة الأمد كذلك، باسترجاع معلومات من مواد مخزونة سابقًا. وأخيرًا، وظيفة الذاكرة طويلة الأمد هي تخزين البيانات من خلال نماذج وأنظمة مختلفة. من هنا نرى بأهميّة استرجاع الذكريات عن وعي وإدراك.
شعبان (2024. ص38-41) تعتمد على الشكلاني الروسي بوريس توماشفسكي وتقول: “بحسب مفهومه البنيويّ، فإنّ للسرد الروائي أسلوبين سرديّـين: سرد موضوعي objective وسرد ذاتيّ subjective، في السرد الموضوعيّ يكون الكاتب مطّلعًا على كلّ شيء، حتى الأفكار السرديّة للأبطال. أمّا في نظام السرد الذاتيّ، فإنّنا نتتبَّع الحكي من خلال عينَي الراوي أو طرف مستمع……. عن هذين الأسلوبين السرديّـين تنشأ جملة من التقنيّات المختلفة: تقنية الاسترجاع أو الفلاش باك (flashback)، وتقنية المونولوغ وتقنية الأحلام والرؤية من الخلف والرؤية مع، أو الرؤية المصاحِبة والرؤية من الخارج”
تميّز السرد في “منزل الذكريات” بهذه التقنيّات التي يتسّم بها تيار الوعي، مثلًا: تخيّل حالات مختلفة مع زوجته سناء التي “ماتت قبل غروب الشمس بثلاث ساعات” (ص 9) هو نفسيّ – سيكولوجيّ لأنّه أحلام يقظة، فيقول مسترجعًا “أسكب فنجان قهوة لسناء وفنجان قهوة لي. أشرب قهوتي وأنا أتذكّر جلساتنا الحميمة في الصبح”(ص 13)، ومثال آخر “جاءت في الليل وهي ترتدي القميص الداخليّ الذي اعتادت ارتداءه في ليالينا التي لا تُنسى” (ص 28)، مثال ثالث “ثم جاءت سناء، وراحت تتشمَّم جسمي؛ لعلَّها تعثر على روائح امرأة أخرى، سألتني: “أين كنت؟” (ص43)، مثال رابع: “كيف عرفت سناء أنني انتقلت إلى غرفة نومٍ ثانية، وأنَّ سريري أصبح يشكو من الفراغ الفاغر فاه في الليالي الطوال” (ص 110). كيف يحدث هذا وهي ميّتة؟
المونولوج هو حوار داخليّ فرديّ تقوم به الشّخصيّة مع ذاتها وتعُبِّر عن مشاعرها الداخليّة وانطباعاتها وتجاربها الخاصّة. يفتتح الراوي حديثه ب ـ”قلت لنفسي” كما في المثال التالي: ” قلت لنفسي: اسمهان امرأة عركتها الحياة وأنضجتها على نحوٍ لافت للانتباه، ثم صرفت نظري عنها وعن كلامها، وانصرفت إلى قراءة كتاب كاواباتا “منزل الجميلات النائمات”، وكتاب ماركيز “ذكريات عن عاهراتي الحزينات” (ص 34). وايضًا “قلت لنفسي: أحيانا يأتي رهوان في وقت غير ملائم، فيجعلني غاضبا منه ثم لا ألبث أن أسامحه لأنّه ينطوي على صدق لا جدال فيه” (ص 44).
ومثال يتداخل فيه (المونولوج) مع الحلم: “قالت لي في حلمي: سيُلحق بي هذا العجوز أذىً كبيرًا؛ لأنَّ لسانه فالت ولا يتورَّع عن الثرثرة من دون محاذير، وسيعرّضني كلامه الفجّ لمشكلة فادحة مع القحب الجاهل زعيم الزعران” (ص 131).
يسترجع الراوي ويحلم بحالات مختلفة في المرجعيّات، في الروايتين، هذه مقابلة بين حالتين. ما يحدث معه مقابل ما حدث في المرجعيّات الروائية، مثلًا: “نثرت فريال شعرها على صدرها في حركة إغراء، حتّى كدت أتخلَّى عن العجوزين المذكورين، وأختارها هي من دون غيرها لقضاء وقت ما معها” (ص 31). ومثال ثان: “تأملتها بإعجاب وقلت باختصارِ وحسمٍ مثل بطل في رواية يكتبها روائي غير مبذِّر في توظيف الكلمات: أريدها لثلاث ساعات مستغرقة في النوم إلى جواري في السرير، هكذا فعل كلٌّ من عجوز كاواباتا وعجوز ماركيز” (ص 35).
نعتقد أن هذا الخليط يجعل من أسلوب السرد خليطًا من الذكريات التي يسترجعها ومن الأحلام والمونولوج التي يقوم بها عن وعي وإدراك.
اللغة:
“اللغة هي الوسيلة التي نُعَبِّر بواسطتها عن واقعنا وعن خيالاتنا، وعن همومنا وأفراحنا. وحين نجمع ما بين اللغة والخيال نستطيع أن نصل إلى المدى الأبعد والأعمق، ويصبح العالم أوسع وأغنى وأكثر شمولية” (كامل، 2022. ص 39).
لغة الرواية سهلة، انسيابيّة، قريبة من الناس، فهي تتجاوب مع البيئة الاجتماعيّة، مثلًا “سميرة المزيونة” (ص35). “أنا أعرفكم يا شوعيّة …ويلكم عند الله” (ص 65). والواقع الفلسطينيّ وتعكس حياة الناس الواقعين تحت الاحتلال، مثلًا: “أنت تعرف أنّنا نعيش في غابة، وأنّ هذا الاحتلال أفسد حياتنا”(ص 59). و”هذا الزّمن الغشوم” (ص 97). نجد في الرواية أمثالًا شعبيّة مما يزيدها أصالة ومصداقيّة، وعلى سبيل المثال: “فيكم الخير يا ولدي” و”أعزب دهر ولا أرمل شهر”، “العين بصيرة واليد قصيرة”، “أكثر من القرد ما سخط ألله” (ص35) “عمى يعمي عينك” (ص 51) و”ولا يهمك يا رهوان، على صرمايتك، وما يسقط من السماء تتلقاه الأرض” (ص 158) وغيرها.
اللغة في “منزل الذكريات” على نوعين: اللغة السرديّة واللغة الحواريّة (الداخليّ والخارجيّ).
السرد: يعرّف لغةً كما ورد في معجم المعاني: “سَرَدَ: قرأه بالتتابع؛ وأجاد سياقه، ويقال يَسرُدُ آيات من القرآن: أي يقرؤها قراءة سريعة، وسَرَدَ وقائع الحادثة: أي ذكرها حسب تسلسلها، وسَرَدَ الحديث: عرضه ورواه، قصّ دقائقه وحقائقه، “سرد القصّة ونحوها، سرد أخبارًا ووقائع وتاريخًا.
السَّرْدُ في القصة أو الرواية: يعني رواية الوقائع. في الغالب يكون هذا الأسلوب هو المسيطر. مثال من “منزل الذكريات”: “بعد ثلاثة أيام ٍمن كسر زجاج النافذة وعمليّة الاختطاف جاء جميحان. دقَّ على الباب بخشونةٍ ذكَّرتني بطريقة أخته أسمهان في الدقّ، سارعت إلى فتح الباب، رحَّبت به، وكانت سحنته لا تنبئ بأي خير…” (ص65).
الحوار: “الحوار من أهمّ الوسائل المستخدَمة في رسم وبناء الشّخصيّة الروائيّة، فالشّخصيّة الروائيّة لا تُبنى من خلال أفعالها فقط، ولا من خلال أقوال الآخرين عنها فحسب، بل تُبنى، أيضًا من خلال ما تقول. حين تتحدّث الشّخصيّة مباشرة وتحاور جهرًا تكشف عن دواخلها وتُعَبِّر عن نفسها”. (عساقلة، 2024. ص109).
الحوار الداخليّ (المونولوج): انظر في الصفحة السابقة عن التعريف والأمثلة تحت عنوان المونولوج.
الحوار الخارجيّ: هو حوار بين اثنين أو داخل مجموعة، يتبادل فيها الأفراد الأفكار، والاحاسيس، والآمال، والهواجس والأحلام، وهكذا نتعرّف إليها، مثال من “منزل الذكريات”: ” سألني المحقّق: ما علاقتك بفؤاد العبداللات؟
– قلت: هو حفيد أخي محمود، لكنَّني لا ألتقيه ولا أعرف عنه شيئًا.
هزّني من كتفي وضغط على عنقي، ثم سألني:
– ألم تُحَرّضه على قتل الجنود، وعلى قتل أبناء إسرائيل الساكنين في المستوطنات؟
– قلت: لم أحرضه ولم يسبق أن دار بيني وبينه حديث”. (ص 75).
الشخصيّات:
في منزل الذكريات نلتقي مع محمّد الأصغر، سناء، رهوان وقيس، فريال وسميره وأسمهان، وجميحان ومحمّد الكبير. ومن ناحية أخرى نلتقي مع شخصيّات كواباتا الياباني وماركيز الكولومبي ومع تمثال سيمون بوليفار (ص 175)، وتتداخل مع شخصيّات أدبيّة وتاريخيّة؛ كأحمد شوقي، خليل السّكاكيني، الحجّاج بن يوسف، عليّ بن أبي طالب، وأبي ذرّ الغفّاريّ، وكتاب أخبار النّساء لابن القيّم الجوزيّة، وشعر الأصمعيّ، وعلقمة، هكذا تحمل الرواية بعدًا عالميًّا يلتقي فيه الشرق مع الغرب، القديم مع الحديث.
الراوي في الرواية هو راوٍ متكلّم بضمير الأنا هو محمّد الأصغر الذي يسرق منه أخوه قصصه ورواياته وينشرها باسمه. الراوي المتكلّم وهو عادةً بطل يروي قصّته بضمير الأنا غالبًا، المتّصل بالماضي مثل “جئتُ، قلتُ” أو بالمضارع مثل “أجيء، أقول” هكذا يكون حاضرًا في الحكاية. الراوي في الرواية هو بطل القصّة محمّد الأصغر ويرمز إلى عجوز فلسطينيّ فقد زوجته سناء التي ترمز إلى فقدان الفلسطينيّ لوطنه؛ فيعيش بوحدة وغربة.
رهوان ابن عم محمّد الأصغر، شاب خفيف الظلّ، يتصرّف كأنّه عالم بكل شيء، ويريد مساعدة محمّد الأصغر، بأخذه إلى بيت فريال للمتعة، أما محمّد الأصغر فلا يكنّ له الاحترام إذ قال له: “من هم على شاكلتك لا يراقبهم الاحتلال”.
ترمز فريال إلى المرأة الشرّيرة التي تدير نزلًا للدعارة في مستوطنة يهوديّة، وكما يبدو يغضّ الاحتلال الطرف عنها. ترمز الفتاة سميرة إلى الفتاة المسكينة غير الراضية من ظروفها، وترمز أسمهان، إلى المرأة المغلوب على أمرها والخاضعة لسيطرة أخيها واستغلالها لمصلحته الشخصيّة.
جميحان يمثّل الشرّ بعينه، والطمع، واستيلائه على أملاك محمّد الصغير، عن طريق استغلال أخته اسمهان، يتصرّف تمامًا كالاحتلال الذي يستولي على الأراضي الفلسطينيّة بدون رادع.
ملخّص
قمنا في هذه الدراسة بمحاولة الوصول إلى ما بعد النص. وجدنا الرواية مثيرة تنتمي إلى تيّار الوعي في أدب الحداثة ويسترجع فيها الراوي ذكرياته بوعي وإدراك. لغتها سهلة للمتلقي وتجذبه للاستمرار في قراءتها بترصيعها بالعديد من الأمثال الشعبيّة والتعابير اليوميّة، وبأسلوب السرد العادي والحوار الداخليّ (المونولوج) والخارجيّ. وجدناها غنيّة بالالتفات إلى نصوص أدبيّة قديمة وحديثة ونصوص عالميّة: اليابان وكولومبيا وشخصيّات عربيّة وأجنبيّة.
الهوامش
1. “Tchaikovsky -Sleeping Beauty Waltz” باليه مكوّن من مقدّمة وثلاثة فصول، عرض للمرة الأولى في عام 1890 (https://www.syr-res.com/article/6245.html
“الجميلة النائمة” أو “الجمال النائم” هو باليه آسر وساحر من تأليف الملحن الروسي الشهير بيتر إيليتش تشايكوفسكي. تمّ تأليف هذه المقطوعة بالتعاون مع مصمّم الرقصات ماريوس بيتيبا، والمعروفة أيضًا باسم Op. 66. تدور أحداث فيلم “الجمال ” في عالم خياليّ، ويحكي قصة الأميرة أورورا، التي لعنتها جنيّة شرّيرة وتقع في سبات عميق، مع مملكتها بأكملها. تجسّد موسيقى تشايكوفسكي ببراعة الأجواء السحريّة والفخمة للباليه، وألحانها الساحرة، وتناغمها المعقّد. من الفالس الافتتاحي الآسر إلى “Rose Adagio” الشهيرة والخاتمة المبهرة، تنقل النتيجة الى المستمعين بسهولة إلى عالم خياليّ من الحبّ والسحر والصحوة. تعكس الموسيقى الإيقاعات العاطفيّة المختلفة والمشاهد الدراميّة للباليه، بدءًا من اللحظات الرومانسيّة الرقيقة وحتى مشاهد الرقص المفعمة بالحيويّة. تستمر “الجميلة النائمة/ الجمال النائم ” في أسر الجماهير بجمالها الخالد، وفنّها الموسيقيّ الدائم.
2. التلميح Allusion: هو تضمين الكلام إشارة إلى آية، أو قول، أو بيت من الشعر، أو حادثة، أو قصّة معروفة كالتعريض بكلمة، أو عبارة لها معنى بعيد. وهو كما عرّفه أهل البديع: أن يُشير المتكلّم في نصّ معيّن إلى قرينة سجع، أو قصّةٍ معلومةٍ، أو نكتةٍ مشهورةٍ ،أو بيت شعرٍ حُفِظَ لتواتُره، أو إلى مثلٍ سائر يجريه في كلامه، وكلّ ذلك على جهة التمثيل. تعتبر الإشارات، والتلميحات، أقدم وسيلة للتعبير عن كنه المشاعر، وكشف خبايا النفس، قبل استخدام الكلمات المنطوقة، والتعبير بالكتابة: إذ تتمثّل تلك الإشارات في كل ما يأتي به البشر من حركات، ولفتات، ولمزات، وإيماءات من شأنها توضيح السياق وتوصيل المعنى. (موقع موسوعة اللغة العربية. المَبْحَثُ الخامِسُ: التَّلميحُ.)
3. التناصّ Intertextuality: التناصّ اصطلاحًا هو العلاقة التي تربط نصًّا أدبيًّا بنصّ آخر، أو استحضار نص أدبيّ داخل نصّ أدبيّ آخر، وهو ُمرتبط بوجود علاقات بين النصوص المختلفة، ويقوم على فكرة عدم وجود نصّ بدأ من العدم، فكلّ نصّ موجود هو ُمعتمد في وجوده على نصّ آخر، إمّا في الفكرة وإمّا في استخدام التراكيب والألفاظ. (العنزي، ص549. 2023).
4. أدلة MSD لمحة عامة عن الشيخوخة حسب: Richard W. Besdine, MD, Warren Alpert Medical School of Brown University-
https://www.msdmanuals.com/ar/home
المصادر
خليل، سليمة. (2011). تيار الوعي، الإرهاصات الأولى للرواية الجديدة. مجلة المَخبَر، أبحاث في اللّغة والأدب الجزائري. جامعة محمد خيضر. بسكرة. الجزائر.
شعبان، روز اليوسف. (2025). المنفى والاغتراب في روايات غالب هلسا. أ. دار الهدى للنشر والتوزيع.
شقير، محمود. (2024). منزل الذكريات. صدرت عن نوفل. دمغة الناشر هاشيت أنطوان. بيروت.
عساقلة، عصام وخديجة مرعي. (2024). بناء الشّخصيّات في روايات أيمن العتوم. دار يزن للنشر والتوزيع. دالية الكرمل. حيفا.
العنزي، عنود عبد الجبار. (2023). التناصّ بين النقد العربيّ والنقد الغربيّ. المجلة الأكاديميّة للأبحاث والنشر العلميّ. الإصدار السابع والاربعون (5.3.2023). قسم اللغة العربيّة-جامعة الاسكندريّة.
غابرييل غارثيا ماركيز. (2004). ذكريات عن عاهراتي الحزينات. ترجمة د. طلعت شاهين. منتدى الأزبكيّة. مدينة 6 أكتوربر. مصر.
غنايم، محمود. (1992). تيار الوعي في الرواية العربيّة الحديثة. دراسة أسلوبيّة. بيروت -دار الجيل.
كامل، رياض. (2022). المتخيّل السرديّ العربيّ الحديث. الأهلية للنشر والتوزيع. عمّان.
الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري. (2014). مجمع الأمثال تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الأولى. بيروت: دار المعرفة. https://www.syr-res.com/article/24001.html
ياسوناري كاواباتا. (2006). الجميلات النائمات. ترجمة ماري طوق. دار الآداب. بيروت.
موقع موسوعة اللغة العربيّة. المَبْحَثُ الخامِسُ: التَّلميحُ.
https://dorar.net/arabia/2069/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8
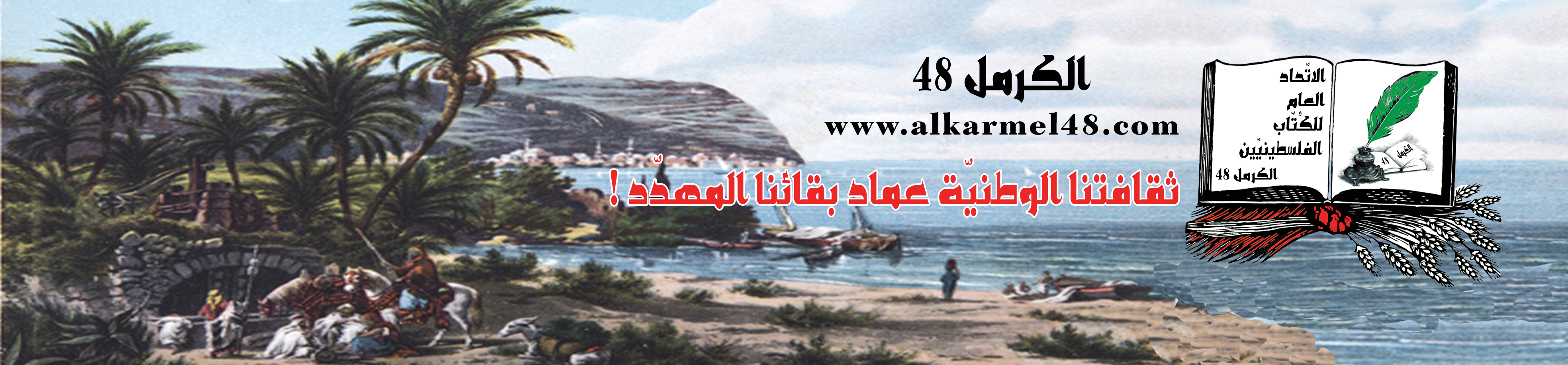 Alkarmel 48 الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48
Alkarmel 48 الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48