“على ضـفـاف نهـر الحبّ / أحمـل ريشتي وقيـثارتي وقـلمي /
وأسير على ضفـاف نهــر الحبّ / نهـر مياهه زجاجيّة ناعـمة /
وفي أعماقـــه حجارة من نار / أعزف له لحنًا / أكتب له شعرًا /
وأرسـمـه / ولـكـن إلى مـياهـه لا أقـرب /لأنّهـا تـزيـدني ظــمأ /
وأعماقه تحرق أعماقي……….”
(تغريد حبيب من قصيدة “على ضفاف نهر الحبّ”)
مدخل
كيف نقرأ رواية الكاتبة تغريد حبيب ” القبلة السوداء”؟ هل العنوان الرئيسيّ “القبلة السوداء” ولوحة الغلاف لـ “فتاة مغمضة العينين مطبقة فاها بيدها وغير واضحة الـمعالـم” ومقطع البداية (العرض أو التقديم) تحت العنوان الفرعيّ “في الـمرسم” كعتبات للرواية. هل هذه الـمركّبات تُشَكِّل دليلًا لمتن الرواية؟ وعليه سنحاول دراسة هذه الرواية حسب الـمركّبات أعلاه. سنحاول اختراق الـمتن لمعرفة رسالة الكاتبة للمتلقّي. ماذا تريد أن تقول؟
العتبات
القبلة السوداء: العتبة الرئيسيّة، وهي عنوان إغرائيّ يثير انتباه الـمتلقّي واهتمامه ويحثّه على الاستمرار في القراءة، ومن الـمتوقّع أن تحتوي لغة السرد على تقنيّات أخرى تحثّ الـمتلقّي على الاستمرار، مثل: تلميحات وإشارات وإيحاءات ولغة محكيّة وأمثال شعبيّة وغيرها.
القبلة السوداء هو إرداف خُلفيّ Oxymoron وهو صورة بيانيّة تجمع لفظتين متناقضتين ظاهريًّا ممّا يمنحهما معنى جديدًا (وهبة والـمهندس، 1984، ص 24).
القبلة: التقبيل أو البَوْس، وهو تلامس الشفاه بأيّ شيء. وتختلف دلالاتها من ثقافة لأخرى اعتمادًا على الثقافة والسياق. فالقبلة يمكن أن تعبّر عن مشاعر الحبّ والعاطفة والرومانسيّة والانجذاب الجنسيّ والـمودّة والاحترام والتحيّة والصداقة والسلام وأشياء أخرى كثيرة. في بعض الحالات تعدّ القبلة أحد الطقوس الرسميّة أو رمزيّة تشير إلى الإخلاص والاحترام.
ويختلف ما تشير إليه باختلاف مكانها، فقبلة الجَبين عنوان للسموّ، وقبلة الوجنتين والخدود رمز للحنان والحبّ، وقبلة القدم رمز للخضوع، وقبلة الأيدي رمز للتقدير والاحترام.
اللّون الأسود: هو أغمق الألوان ويمثّل الظّلام الكامل وانعدام الرّؤية، ويعدّ رمزًا للحزن والالـم والـموت والخوف من الـمجهول والعدميّة، وقد شُحن هذا اللّون في الشّعر العربيّ بدلالات عديدة، وارتبط باللّيل بكلّ ما فيه من رهبة ومخاوف وخيالات مرعبة وإحساس بالعدميّة والضّعف، وارتبط بالتّشاؤم، وكان الغراب رمزًا للتّشاؤم نظرًا لسواده فهو رمز الفراق، كذلك ارتبطت صورة الأفعى السّوداء بالشّرّ والـموت.
عند معظم الشّعوب هو لون الحداد، ويتمّ ارتداؤه في الجنازات. ويُنظر إليه عند البعض بأنّه اللّون الخاصّ بالتّمرّد والعصيان، لذلك سمّيت، على سبيل الـمثال، حركات ثوريّة باسم “الفهود السّود” أو “اليد السّوداء” وغيرها (طنّوس، 2021، ص 58 و74).
يقول عبد الغني صدوق (2022): “القبلة السوداء، سوداء لأنّها تترك إحساسًا موجعًا بعد التوقيع مباشرة إذا أُخذت بغير وجه حقّ، ولعلّها تتكرّر ويتكرّر معها الوَجع، مسجونة هي النّفس اللوّامة بين قضبانها، مأسورة في الصباح حرّة في الـمساء وهكذا دواليك”
عبير، الشخصيّة الـمركزية، تكشف حقيقة “القبلة السوداء” وتحكي لأبي أيّوب (وزياد) لماذا طردها زياد قائلًا “غدرتني يا فنّانة!” (ص 127) بعد أن حكى له أخوه أيّوب عن علاقته بها: “اِقترب منّي (أيّوب)، حاولت أن أبعده لكنّني ضعفت، قبّلني، وبعد لحظة استيقظت من “قبلتي السوداء” بقلب حزين، هربت من الـمكان، بعد أن قلت له ولنفسي إنّ ذلك لن يتكرّر، عدت إلى بيتي بقلب أسود مظلم، حضنت قبّعة زوجي الشتويّة وبكيت، وطلبت منه أن يسامحني” بكت عبير وتابعت تقول لأبي أيّوب: “أنا لست امرأة رخيصة عمّي” (ص 129).
لوحة الغلاف لـ “فتاة مغمضة العينين ومُطبقة فاها بيدها، والوجه غير واضح الـمعالـم. توحي إلى ملامح فتاة صامتة وإلى تأمّل فيه حزن وتخبّطات حول صراع معيّن وتساؤلات ما هو الحلّ في مجتمع يريدها أن تصمت وأن يحدّد لها كيف تعيش؟
البداية -exposition: البداية أو العرض أو التقديم أو البيان التفسيريّ هو ذلك الشكل من القول الاستدلاليّ الذي يشرح ويعرّف ويفسّر، وهو يضمّ كلّ أنواع التأليف الأدبيّ الشفاهيّ والكتابيّ. وينطبق الـمصطلح على الأجزاء الابتدائيّة في الحبّكة حيث تعرض الـمادّة التي تشكّل الخلفيّة (فتحي، 2010، ص 71). ويسميها محمّد حمد (حمد، 2018، ص 9) البداية The Beginning.
البداية (العرض أو التقديم) في رواية “القبلة السوداء” جاءت تحت العنوان الفرعيّ “في الـمرسم” (ص 7). الـمرسم هو مركز الأحداث، فيه وصف للحالة وللأجواء: الرياح تعصف، يطرق، يجلجل، عواصف رعديّة، ألسنة ناريّة، الأمطار تستولي على الـمكان وتتلف لوحات تحمل كلّ منها حكاية وذكريات.
هل هذه البداية تلمّح إلى أجواء الرواية؟ ماذا تؤثر على الـمتلقّي؟
هذه البداية دراميّة ومنها تنطلق أحداث الحكاية فيها، إشارات وتلميحات وإيحاءات للأحداث وتتكّئ على الإخبار والإغراء فتثير انتباه الـمتلقّي واهتمامه وتحثّه على الاستمرار في القراءة.
تعود البداية وتتكرّر في فصل “الـمطر الأسود” (ص 137) لتغلق الكاتبة الحكاية وتضعها في دائرة مغلقة لتحافظ عليها كمن تريد إخفاءها ولتفسح الـمجال لحكاية جديدة.
ملخّص الرّواية:
رواية “القبلة السوداء” تتحدّث عن عمليّة استذكار فنّانة في مرسمها، وهي الشخصيّة الـمركزية “عبير” التي كانت مركزًا لجميع الأحداث الـمفعمة بالحياة والحركة اللتين تعطيان مكانًا تلعب فيه شخصيّات أخرى تخدم الشخصيّة الـمركزيّة وسيرورة الأحداث في الـمرسم وغيره، الـمرسم الذي يغمره الـمطر ويسبّب تلف بعض اللوحات، وكلّ لوحة تأخذها بالذكريات الى أحداث من حياتها: “الرياح تعصف في الخارج بشدّة…… الـمطر يطرق النوافذ بقوّة… والعواصف الرعديّة مثل ألسنة ناريّة تحرق شغاف قلبها…. والـمياه تتسرّب إلى أطراف لوحاتها الورقيّة ورسومات القماش التي يحمل كلّ منها حكاية وذكريات، فتتلف معظمها ساخرة من مستقبلها الذي حلمت بأن يكون عظيمًا”(ص 7).
الرواية تطرّقت لمواضيع كثيرة ومهمّة في حياة الـمجتمع الفلسطينيّ خاصّة والـمجتمع العربيّ عامّة، مثل حكايات حول العلاقة بين الجنسين، ومكانة الـمرأة عامّة والأرملة والـمطلقة خاصّة، والعنف ضدّ الـمرأة وغيرها الكثير من الأنماط السلوكية والعادات والتقاليد. تقول عبير لصديقتها منال: “قد نُقتل دون سفك دم، ودون سلاح، وقد نموت في هذه الحياة دون أن تفارقنا الروح، كم من النساء يَعِشن دون حرّيّة وتقدير وتحقيق للذات؟” (ص 148)
تمتدّ الرواية من حكايات الجدود والجدّات لتصل الأحداث إلى كارثة وباء أرعب البشريّة جمعاء وهدّدت حياة الناس، كوفيد-19، ربّما ليحذّر الناس عن طريق الـمتلقّي من الأخطار الكامنة في صدور البعض بالإضافة إلى خطورته كمرض فتّاك، ودعوة للتحلّي بالحبّ والتسامح والعفو واحترام الآخر، هذه تقود الإنسان إلى برّ الأمان. تمضي أحداث الرواية لتكشف مواقف عديدة وحكايات متنوّعة، يرافقها الفنّ والإبداع، ونجد الـمرسم وفيه اللوحات والألوان والريشة والـموسيقى والبيانو ومن الناحية الأخرى نجد السكّين والـمسدّس. هذه ثنائيات ضدّيّة تثير الـمتلقّي وتشدّه للاستمرار في القراءة.
نجد للواقع الفلسطينيّ تحت الاحتلال حيّزًا لا بأس به في الرواية، مثل “فاجعة وفاة أطفال من زخّات القنابل الفوسفوريّة في غزّة” (ص 18) “وبلادنا تنتفض غضبًا على الحكومة غير الـمباليّة للعنف الـمستشري” (ص 36) وغيرها.
الرواية تطرح قصّة حبّ غير معهودة، حبّ مهدّد بالعنف الـمنتشر في الـمجتمع في كلّ مكان، عنف ضدّ الصغار والكبار والرجال والنساء وتكون بين ضحاياه نساء لمجرّد كونهنّ نساء، والفاعل شابّ متهوّر، وامرأة حاقدة وغيورة، وزوج عنيف يدمي وجه زوجته. ومنال تعاني الأمرّين من زوج لا يسمح لها بأن تتنفّس الهواء، فتكون العاقبة التعنيف والإهانة حتّى أجبرها أسلوبه على أن تكذب” (ص 34).
تبرز في الرواية العديد من الشّخصيّات، بينها: الشخصيّة الرئيسيّة “عبير” الفنّانة التشكيليّة الأرملة، وابنها الوحيد “آدم”، تَرَمُّلِها في جيل صغير جعل حياتها مليئة بالقهر والجفاف ومن حقّها الحياة، لكنّ الـمجتمع يقف سدًّا منيعًا أمامها وأعينه تراقب كلّ حركة (ص 24) وهذا ما يخيف عبير وهكذا عاشت في الرواية مع ابنها “آدم” في قرية فلسطينيّة، حيث “قتلت لارا، ووُجدت في حاوية القمامة” (ص 33)، وهو الخبر الذي كان وقعه قاسيًا جدًّا على رؤوس أهل القرية. وكانت هذه الحادثة دافعّا لعبير أن تنتصر لقضيّة الـمرأة وأن تبرز أدوارها البنّاءة في الـمجتمع والدعوة لمظاهرة كبيرة للتنديد بالعنف وقتل النساء خصوصًا (ص33-34).
“أيّوب” شخصيّة قريبة من “عبير”، فهو مِثلها فنّان تشكيليّ وبينهما قصّة حبّ كبيرة (ص 27-28) ولكن عبير تواجدت في صراع بين حبّها لأيّوب وحبّها لابنها آدم، فتقول لابنها آدم عندما سألها إذا كانت تحبّ الفنّان أيّوب الذي رسمها: “إنّه (أيّوب) متزوّج، كما أنّي لا أسمح لأي حبّ أن يأخذني منك”(ص26) وصراع آخر بين حبّها لأيّوب وإخلاصها لذكرى زوجها ممّا أوقعها في حساب الذات (ص 30).
سافر أيّوب إلى مصر للاطمئنان على جدّه هناك، وكان قد اتّفق مع صديقه “جهاد” من غزّة أن يلتقيا في القاهرة، لكنّه اعتُقل في الـمطار وحُقِّق معه إذا كانت له أيّة علاقة بخلايا إرهابيّة (ص 41) بينما اعتقل “جهاد” في الـمعبر، والتقيا في زنزانة مصريّة واحدة، بعد أن تورّط الثاني في تهمة التعاون مع الاحتلال في اغتيال بهاء أبو العطا في حضن زوجته بقصف من قبل طائرات الاحتلال (ص 35). وكان أبو العطا قياديًّا في حركة الجهاد في غزّة (ص 44).
بعد سفر أيّوب إلى مصر ومكوثه في السجن حدثت الـمفاجأة مع زياد الضرير شقيق أيّوب. حضرت عبير برفقة منال إلى بيت عائلة أيّوب لتسألا عن أيّوب وفي البيت جاء زياد “يقرع بعصاه مستدلًّا طريقه، كادت عبير تصرخ باسم أيّوب… أنا زياد أخو أيّوب … أُعجبت عبير بهذا الكفيف الذكيّ وبجمال روحه وثقته بنفسه…” (ص 51-53) هكذا بدأت قصة حبّ بين عبير وزياد الـموسيقيّ الضرير شقيق أيّوب. السؤال الهامّ هنا: كيف تطوّرت العلاقة بين أيّوب وعبير من ناحية وبين زياد وعبير من الناحية الأخرى؟ وكيف كان تأثير كلّ هذا على “هناء” زوجة أيّوب. لن أخوض بهذا هنا فأتركه للمتلقّي، ليستمتع بقراءة سيرورة الرواية والـمفاجآت الكثيرة.
يخرج “أيّوب” بعد أن يثبت أن علاقته بـ “جهاد” ليست إلّا علاقة فنّان بمعجب، بينما يبقى الآخر حبيسًا، رغم إصراره أنّه لم يقم إلّا بمهاتفة “أبو العطا”، قبل أن يتفجّر بيته بدقائق فقط، من أنّه هو من يسكن البيت (ص 45).
بالإضافة إلى أيّوب وعبير وآدم وزياد نلتقي بهناء ومنال وسعيد وأبي السعيد ووالد أيّوب والـمحقّق الـمصريّ والضابط التركيّ وغيرهم من شخصيّات عالـميّة، مثل: جواكين رودريغو
الضرير صاحب الـمقطوعة الـموسيقيّة مونامور، فان غوخ ودافنشي وموتسارت وخوليو.
الشّخصيّات
تقسم الشخصيّات في الرواية إلى ثلاثة أنواع:
أ. الشخصيّة الرئيسيّة (الـمركزيّة، الجوهريّة، الـمحوريّة، البؤريّة).
ب. الشخصيّة الثانويّة: تضيء الجوانب الخفيّة للشّخصيّة الرئيسيّة، وهي مرافق أساسيّ للشّخصيّة الرئيسيّة من أجل سير الأحداث وتوازنها (عساقله ومرعي، 2024، ص61-62).
ت. الشخصيّة الهامشيّة: يعتبرها البعض ثانويّة ولكنّها أقلّ حضورًا من الثانويّة، فتظهر في حدث عابر أو اثنين وتقوم بدور هامشيّ، في حدث معيّن أو موضوع محدّد أو غرض عَيْنيّ (أدْهوك Ad hoc) وعند عساقله ومرعي (ص 62) يُطلق عليها اسم الشخصيّة الثانويّة.
من حيث ارتباط الشّخصيّات بتطور الأحداث، تُقسم الشّخصيّات إلى ثلاثة أنواع:
أ. الشخصيّة النّامية (الـمتحرّكة، الـمتطورّة، الـمدورّة). هي شخصيّة تتطوّر من موقف لآخر، ويظهر لها في كلّ موقف تصرّف جديد يكشف عن جانب جديد.
ب. الشخصيّة الثّابتة (الـمسطّحة، الجامدة). هي الشخصيّة التي تُبنى حول فكرة واحدة، لا تتغيّر طوال الرواية، لا تتطوّر ولا تثير دهشة القارئ.
ت. الشخصيّة النّموذجيّة (النّمطيّة) هي الشخصيّة التي يرسمها الروائيّ بوصفها ممثّلة لطبقة من الطبقات أو لجيل من الأجيال، ليبرّر فيها اتجاهات تلك الطبقة أو ذلك الجيل أو سماتها الـمميّزة (عساقله ومرعي، 2024، ص 63-64).
الشّخصيّات في “القبلة السوداء”
عبير: هي الشخصيّة الرئيسيّة التي تتطوّر من موقف لآخر. هي فنّانة تشكيليّة وأرملة وأمّ آدم. تدور حولها الأحداث والشّخصيّات الأخرى تدور في فلكها. عبير مرهفة الحسّ، مفعمة بالحنان والعطف وروح التسامح، وعلى الرغم من الصعوبات الحياتيّة والعوائق والتّحدّيات كانت صارمة في تحقيق حلمها. تتطوّر مع سيرورة الأحداث وتتفاعل معها. كانت علاقتها الأولى مع أيّوب وظهرت كأنّها تحبه، ولكنّها عبّرت أنّها تريد معه صداقة لا أكثر وبرّرت هذا بقولها “لن أكون سببًا لدمار بيتك” (ص 71). وتطوّرت علاقتها مع عازف البيانو ومعلّم الـموسيقى الضرير زياد شقيق أيّوب، وأصبحت تستأنس لقربه ويسعد قلبها بالحديث إليه … واستولت على قلبه حتّى خفق بقوّة بينما كان يعزف الـمقطوعة الـموسيقيّة مونامور التي تحبّها بشكل خاصّ، واشتاقت أن يضمّها هذا الرجل الـمفعم بالحسّ.
أيّوب: شخصيّة رئيسيّة ثانية، فنّان تشكيليّ معروف، والده مصريّ وأمّه فلسطينيّة، متزوّج من “هناء”. هو شخصيّة تتطوّر من موقف لآخر، خلال معرض رسوماته تطوّرت علاقته مع عبير، ويقول: “أهلًا بكِ، هل أعجبتك الأعمال؟ راق لي اهتمامك”. ليس مألوفًا أن يبحث الفنّان عن معجبيه ولكن ربّما قول صديقه بأنّها أرملة وقلّما تزور الـمعارض جعله يبادر لشكرها والتقدير لاهتمامها أو قد يكون معجبًا فتطوّرت العلاقة بينهما. سافر إلى مصر لزيارة جدّه، لكنّه اعتُقِل في الـمطار وحُقّق معه. بعد إطلاق سراحه ذهب إلى الـمستشفى لزيارة جدّه وهناك طوّر علاقة مع الـممرّضة “مها”، “اِقترب منها حتّى التصق بها وأحاطها، قبّلها من عنقها. تبادلا القبل بشوق وحميمية”. هكذا هو كما نقول بالـمحكية “نسونجي”. عارض علاقة عبير مع زياد ولكن في النهاية دعمهما.
زياد: شخصيّة رئيسيّة ثانية، موسيقيّ، عازف بيانو ومعلّم عزف البيانو. هو ضرير وشقيق أيّوب. تعرّف إلى عبير وبدأت تتعلّم معه العزف على البيانو. تطوّرت بينهما علاقة حبّ قوية مرّت في حالات حبّ شديد وغضب. تقول عبير لوالد زياد: “أحببت زياد يا عمّي، أحببته بصدق….”(ص129). عندما حاول أيّوب إبعادها عن زياد. نجح زياد وأيّوب أن يتزوجا ويقيما “معهد الـمحبّة للفنون”.
شخصيّات ثانوية: أبو السعيد والد عبير، هناء زوجة أيّوب، منال، آدم ابن عبير.
أبو السعيد، كما تقول عنه الـممرّضة سماح: “لطيف، هادئ، مثقّف، جميعنا نحبّه” توفّي في بيت الـمسنّين نتيجة لإصابته بالكورونا.
هناء زوجة أيّوب، وابنة خالته، اِمرأة جميلة وغيّورة جدًّا. كادت تؤدّي إلى عمليّة إجراميّة بسبب غيرتها من عبير وذلك بتحريض أخيها ربيع الـمجرم ذي الشّعر الأشقر، فقام بمحاولة الاعتداء عليها والتخلّص منها.
منال صديقة عبير وأيّوب وهي امرأة مُعَنّفة من زوجها.
آدم هو ابن عبير، وحيدها. يتعلّم الـموسيقى في باريس.
شخصيات هامشيّة: الجندي التركيّ، الضابط التركيّ خاقان، أم السعيد، العمّ نعمان، لارا، موسى الـمجنون، جهاد، الشرطيّ، نزار ابن أيّوب، صالح السجّان، سماح الـممرّضة في بيت الـمسنّين، رباب ومها الـممرّضتان في الـمستشفى في مصر، عمّ أيّوب وجدّه، ربيع شقيق هناء.
اللغة والأسلوب السرديّ:
الأدب بكلّ أجناسه، شعرًا وومضةً وروايًة وقصًّة وغيرها، هو نتاج اللّغة، فهي الأساس الهامّ الأوّل لأيّ إنتاج أدبيّ. للأدب مكانة خاصّة وهامّة في الحفاظ على اللغة والارتقاء بها من خلال كلّ أشكال الكتابة الإبداعيّة الـمختلفة.
“اللغة هي الوسيلة التي نعبّر بواسطتها عن واقعنا وعن خيالاتنا، وعن همومنا وأفراحنا. وحين نجمع ما بين اللغة والخيال نستطيع أن نصل إلى الـمدى الأبعد والأعمق، ويصبح العالـم أوسع وأغنى وأكثر شموليّة. إنّنا نرى بخيالنا مدًى أبعد ممّا تراه العين، وبواسطته يمكننا خلق ما هو أبعد من الصورة الـمحسوسة، لكنّ هذه الرؤية وهذه الرؤيا تظلّان حبيستي الخيال حتّى نحيلهما إلى صورة كلاميّة. وبالتالي فإنّ الّلغة تنقلها من عالـم الفرد باتّجاه الفضاء الاجتماعيّ الأوسع” (كامل، 2022، ص 39؛ طنّوس، 2024، ص 3).
لغة الرواية سلسة وجذّابة ممّا يساعد الـمتلقّي على التركيز والاستمرار في القراءة والاستمتاع بها، فقد تنوّعت طُرق السرد فيها: السرد بضمير الغائب، الحوار الداخليّ (الـمونولوج)، الحوار الخارجيّ، الحوار النصّيّ الافتراضيّ (بواسطة الهاتف)، اللهجة الـمحكيّة الفلسطينيّة والـمصريّة والتركيّة، وبعض الأمثال الشعبيّة، ونجحت الرواية في نقل حكايات الأجداد، وتصوير شخوصهم تصويرًا واقعيًا ومثيرًا.
السرد بضمير الغائب:
من أهمّ عناصر الرواية عنصر السرد ويقوم به الراوي وهو “شخصيّة وهميّة ووظيفة من وظائف النصّ الذي يخلقه الكاتب مُصَوِّرًا فيه عالـمه وزمانه في الرواية الحديثة، هناك كاتب حقيقيّ وراوٍ وهميّ وإلى جانبهما قرّاء كُثر من لحمٍ ودمٍ يقرؤون النّصّ في خلواتهم (عساقله ومرعي، 2024، ص 30).
يوهمنا الراوي بضمير الغائب في سرده أنّه يعرف كلّ ما يجري وكلّ الحقائق حتّى ما خفي منها، وهو ما يُعرف بـ ” الراوي العليم” أو ” كلّيّ الـمعرفة”، يسرد الأحداث بضمير الغائب ويسردها بشكل محايد، يروي الأفعال والحوار دون الخوض في أفكار أو أحاسيس أيّ من الشّخصيّات، تمنح الكتابة بضمير الغائب الـموضوعيّة وتجرّدها من التوجّه الشّخصيّ. هذه الـموضوعيّة تبعد عن الكاتب شبهة الانحياز ومن ثمّ تمنحه الـمصداقيّة، مثل:
“ارتجفت، شعرت بالبرد يقرس ثناياها… كانت تستعد للخروج، فمنذ أن توفّي زوجها لم تزُرْ صالة التي كثيرًا ما تردّدت عليها” (“القبلة السوداء”، ص7). “ابتعدت نحو طاولة الضيافة في زاوية منعزلة بعض الشيء عن صالة العرض”(ص 15). “كانت كلماته كحوريّات يستلقين عاريات عند شاطئ البحر” (ص 24). “جلس زياد صامتًا يتلقّى ذبذبات الأصوات والحديث من كلّ جانب في الغرفة، إلى أن سمع صوت عبير …” (ص 52). “انبثقت الدموع من عينيه … ابتسمت أمام عينيه …” (ص107). كان زياد يجلس قرب أيّوب، ففتح يده قائلًا ناولني السوار…” (ص154). “تناولت عبير الورقة بلطف، كانت الطّفلة قد رسمت مسدّسًا تنبعث من فوهته أزهار…” (ص 177).
اللَّهْجَةُ الـمحَكِيَّة
هي وسيلة الحوار والـمخاطبة فيها. تختلف أحيانًا من مدينة وقرية إلى أخرى، ومن منطقة جغرافيّة إلى أخرى، ولكن غالبًا تكون مفهومة للجميع. اللَّهْجَةُ الـمحَكِيَّة في رواية “القبلة السوداء” تنوّعت في ثلاث لهجات: اللَّهْجَةُ الفلسطينيّة واللَّهْجَةُ الـمصريّة واللَّهْجَةُ التركيّة. اِستعمال اللهجة الـمحكيّة يزيد من واقعيّتها ومصداقيّتها وتأثيرها الكبير على الـمتلقّي إذ يشعر أنّها وثيقة الصلة فيبتسم أحيانًا أو يضحك وربّما يبكي، فكثيرًا ما تذكِّره بأمور حدثت معه شخصيًّا أو يتذكّر جدّه وجدّته وأمّه وأباه وغيرهم، أمثلة:
اللَّهْجَةُ الفلسطينيّة: “سحلب؟! ومن وين يا حسرة؟ مفش عنّا حليب. بعرفش. دبري حالك يا مرة.” (ص 9). “ما لقيت عنّا حليب، طعميتك من حليبي” (ص10). “اِسمع يا أيّوب! كلّ الفنّانين ملهنش أمان … أنا بس بنبهك حتى تحافظ على سمعتك”. (ص 22). “البلد “قايمة قاعدة” … ألله يصبر أهلها” (ص33).
اللَّهْجَةُ الـمصريّة: والد أيّوب يخاطب عبير بلهجة مصريّة: “هو انت مروّحة؟ لسّه بدري” (ص17). ” يا لهوي إيه ده” (ص 39). “باين عليّ كده يا فندم؟” (ص 42). “طبعًا حنريحك ما تخفش …” (ص 43). “ششششش أخفض صوتك وما تسألش عن الإرهابي ده!” (ص 67). “جالك إفراج يا أيّوب، أمّك دعيالك يا بني” (ص 87). ” انت عظيمه يا مها، كل ده شايلاه لوحدك …” (ص 97).
اللَّهْجَةُ التركيّة: “أطبه أكل أبو سمير”، “آه أبو سمير هذا أطيب سهلب أكلتو” (ص 10). “ست أظيمة أنت أم سمير” (ص 11)
الـمثل الشعبيّ وتعابير منتشرة:
يصف الحالة الآنيّة الـمشابهة للحالة التي نشأ فيها الـمثل، كما تعبر الأمثال الشعبيّة عن ضوابط أخلاقيّة، لتعطي درسًا ولتكون ضابطًا سلوكيًّا أخلاقيًّا لعامّة الناس، تتناقلها الأجيال فتبقى محفورة في ذاكرتهم وقلوبهم. يعكس الـمثل الشعبيّ أفكار الناس وأحاسيسها على اختلاف مستوياتهم الاجتماعيّة والطبقيّة، وهو الـمعبِّر الصادق عن همومهم، وأفراحهم وغيرها. أصل كلّ مثل قصّة أو حادثة جرت يومًا ما، فأصبح ذاكرة الشعب الّتي تعبِّر عن حياة الناس بكلّ جوانبها الخير والشرّ، الجيّد والرديء، الفرح والحزن.
ورد في رواية “القبلة السوداء” العديد من الأمثلة الشعبيّة الفلسطينيّة والـمصريّة وهي مرآة صادقة لحياتهم وتجاربهم، تعكس عاداتهم وتقاليدهم والأنماط السلوكيّة التي سلكوا حسبها، مثل: تعابير منتشرة بلهجة فلسطينيّة “هاي الحكاية حكيتها، وعليكم رميتها، ولو كان بيتي قريب، جبت لكلّ واحد علبة زبيب” (ص 11). “البلد قايمة قاعدة” (ص 33).
أمثال وتعابير بلهجة مصريّة: “يا بني ما أغلى من الواد إلّا ود الواد” (ص 38). “يا لهوي” (ص 39). “ربنا ينور طريقك يا بني ويفك أسرك” (ص 66). “غلاوتك بغلاوة أولادي” (ص 87).
الحوار:
الحوار من أهمّ الوسائل الـمستخدمة في رسم وبناء الشخصيّة الروائيّة، فالشخصيّة لا تُبنى من خلال أفعالها فقط، ولا من خلال أقوال الآخرين عنها فحسب، بل، أيضًا من خلال ما تقول. حين تتحدّث الشخصيّة مباشرة وتحاور جهرًا تكشف عن دواخلها وتُعَبِّر عن نفسها (عساقله ومرعي، 2024، ص 109).
الحوار الداخليّ (الـمونولوچ): هو حديث الشخصيّة مع نفسها، من غير وجود إمكانيّة تواصل وردّ عند الشّخصيّات الأخرى. يُستخدم الحوار الداخليّ في السرد لمعرفة أفكار وأحاسيس ودوافع وأهداف الشخصيّة نحو حدث معيّن. في الحوار الداخليّ تساؤلات، تأمّل ومناجاة وغيرها.
الحوار الداخليّ موجود بكثرة في رواية “القبلة السوداء” وخاصّة من عبير: عندما أرسل أيّوب لعبير لوحة البورتريه التي رسمها لها، قالت في نفسها: “آه، تبدو كإحدى الأميرات كم هو بارع! لقد رسمني! … تأمّلت مرّات ومرّات اللَّوْحَة التي تضيء من هاتفها، كيف كان شعوره عندما وضع الرّموش وألوان الشّفاه والشعر الأسود الطويل؟ لا بدّ أنه في كلّ لون وبقعة ولمسة فرشاة كانت مشاعره تستيقظ هنا وهناك” (ص 21). تقول عبير: “ماذا سيقول أيّوب، أحببت أخاه وسوف يبغضني، ربما سيقذف بلوحتي في القمامة، آه لن يفهمني، لن يفهم أنّي أحتاج إلى حبّ كبير وصادق وحقيقيّ أعيشه مع زياد، أمّا هو فله عائلة تنتظره. آه يا أيّوب! تلك القبلة ستكون سبب تعاستي …” (ص 84-85). يقول أيّوب محدثّا نفسه: “لم تكن (عبير) أنانيّة مثلي، دمّرتُ زياد (شقيقه)، وأحرقتُ أرضًا مزهرة بحبٍّ حقيقيّ، نعم إنّها تحبّ زياد، وهو سيموت إن بقيت بعيدة عنه” (ص133). شعرت الأمّ بفرحة زياد بمعرفة عبير واهتمامه به، فحدّثت نفسها: “آه من هذه العبير! لقد أسرت قلبه وأسعدته، كلاهما يحتاج للآخر، فهي أرملة وحيدة، وهو سجين الظلمة” (ص 55).
الحوار الخارجيّ: هو محادثة بين شخصين أو أكثر، وفيه إمكانيّة تواصل وردّ عند الشخصيّات الأخرى. تعتمد الشخصيّة عليه للحصول على أمر ما من الآخرين، أو الاستفسار أو التعرّف إلى الآخرين أو تقديم أنفسنا لهم أو طرح قضيّة للآخرين، وفي الأساس هو وسيلة التفاعل بين الناس. يساعد الحوار الخارجيّ في العمل الأدبيّ الـمتلقّي على فهم أحداث القصّة وحبكتها والصراعات الـمختلفة بين الشّخصيّات، الحوار الخارجي في رواية “القبلة السوداء” جرى بين: عبير وأيّوب، عبير وزياد، عبير ووالد أيّوب وزياد، أيّوب وهناء، عبير ومنال وبين باقي الشّخصيّات، مثلًا: أبو السعيد وزوجته: “أبو السعيد: الحاقان طلب سحلب. أم السعيد: سحلب؟ ومنوين يا حسرة؟ مفش عنا حليب. أبو السعيد. بعرفش. دبري حالك يا مرة” (ص 9).
أيّوب لعبير: “أهلًا بك، هل أعجبتك الأعمال، راق لي اهتمامك. عبير: تشرّفت بمعرفتك، عبير، فنّانة تشكيلية” (ص 14).
هناء تقول بغضب لأيّوب: من هذه الأنيقة (تقصد عبير) التي تمنحها ابتسامتك الجذّابة، ولماذا تبدو مهتمًا بها هكذا؟ أيّوب: إنّها فنّانة، أرملة، إنسانة محترمة” (ص 22).
في السجن: صباح الخير. قال العمّ صالح السجّان. أيّوب: صباح النور عمّ صالح، كيف أصبحت؟ (ص 66).
عبير وشقيقها سعيد: “حبيبي، أشياء كثيرة أودّ أن أخبرك بها. سعيد: قبل أن تخبريني، وقبل أن أنسى، جاءت صديقتك منال، وسألت عنك، ظنّت أنّك ما زلت هنا، أخبرتها أنّك عدتِ أمس” (ص 109).
الحوار بالـمراسلة: هو حوار عن بعد، وانتشر بفضل التطوّر الهائل في وسائل الاتّصال، وكان آخرها التراسل عبر الانترنت والـماسنجر في الفيس بوك والواتس-أب والـمحادثة بالهاتف. وأصبح التواصل مع هذه الوسيلة الحديثة ينتشر بسرعة بين الأفراد، والـمجتمعات الـمختلفة. ينقص هذا النوع من التواصل حضور الشّخصيّات وجهًا لوجه، فهو غير متأثّر بلغة الجسد، والوقوف أمام الآخر، فملامح الوجه ونظرات العيون غير حاضرة في الحوار، أمثلة:
رسالة من أيّوب إلى عبير (ص 22-23). رسالة من منال إلى عبير (ص 33). رسالة من زياد إلى عبير (ص 83). أيّوب وعبير (ص 85). سعيد وعبير (ص 109). أيّوب وهناء زوجته بعد اكتشافه لمؤامرتها مع أخيها ربيع (ص 152). ورسائل عديدة أخرى.
الحوار في رواية “القبلة السوداء” شّكَّلَ عاكسًا لواقع الحیاة في الـمجتمع الفلسطينيّ: العلاقة بين الجنسين، ومكانة الـمرأة، ووضع الأرملة، والعنف بكلّ أشكاله، داخل الأسرة وفي الـمجتمع عامّة، والاحتلال وتأثيره. أضاء الحوار مضمون الرواية، وكشف عن طبيعة الشّخصيّات ومعرفة أفكارهم وأحاسيسهم وكشف العلاقات الاجتماعيّة. شكّل الحوار في الرواية وسيلة لجذب وإثارة الـمتلقّي ومتعته، خاصّة الحديث باللغة الـمحكيّة واستعمال الأمثال الشعبيّة والتعابير الشائعة التي تجعل من الـمضمون مناسبًا ووثيقَ الصلة به ممّا يشدُّه ويثيره ويمَتِّعه.
بين الواقع والتخَيُّل
الواقع تعني حالة الأشياء كما هي موجودة من حولنا فعلًا مقابل الخيال والوهم، والواقعيّة تعكس الحياة الحقيقيّة كما هي تمامًا وتكون فيها العلاقات الإنسانيّة واضحة والـمكان واضحًا والأحداث حقيقيّة. الواقعيّ يتعلّق بفكرة الشيء بوصفه غرضًا فكريًّا راهنًا وقد يتضمّن تصوُّرًا للواقع، وهو تخيُّل إلى ما يمكن أن يكون. قال جورج برنارد شو: “الخيال هو بداية الإبداع، إنّك تتخيّل ما ترغب فيه، وترغب فيما تتخيّله، وأخيرًا تصنع ما ترغب فيه”.
التّخّيُّل هو قدرة الإنسان على رؤية وتشكيل الصّور والرموز العقليّة للموضوعات والأشياء والإحساس بها بعد اختفاء الـمثير الخارجيّ، كذلك فإن التّخّيُّل عمليّة عقليّة لاسترجاع صور حسّيّة مختلفة وأحداث من الحياة الـماضيّة وتضمينها وتشكيلها لصور ورسوم وأحداث جديدة.
والتخيّل كعنصر روائيّ هو “طاقة الفكر على جمع شذرات النّصوص الـمقروءة والذكريات البعيدة والتجارب الـمختلفة في حركة متّجهة لخلق عالـم الرواية. ولا بدّ لتحليل التخيّل من العودة إلى الـمفردات الدّالّة والصّور الـمتكرّرة وتصنيفها والـمقارنة بينها” (عساقله ومرعي، 2024، ص 32؛ طنّوس، 2024، ص 3).
هل ثمة علاقة بين أحداث الرواية وبين واقع الكاتبة؟
نعتقد أنّه لا أو قلّما توجد رواية نقيّة من أصل أو بذرة حقيقيّة واقعيّة.
في سيرة الكاتبة قرأنا أنّها فنّانة تشكيلية، تمتلك مرسمًا بقرب بيتها، حدثت عواصف وحطّمت الكثير من لوحاتها وهذا ما حدث لمرسم عبير الشخصيّة الرئيسيّة في الرواية. هل اتّكأت الكاتبة على هذه الحقائق وانطلق تّخّيُّلها ونسجت روايتها عليها؟ ما تبقى من أحداث علينا البحث في سيرة الكاتبة ربما نجد أمورًا أخرى اتّكأت عليها.
رسالة الكاتبة للمتلقّي:
جاءت رسالة الكاتبة في روايتها في عدّة تعابير وأخصّ بالذكر وصيّة والد عبير: “الحبّ هو شعلة الحياة” (ص 82)، لأنّ الحبّ يحتوي على الكثير من الـمشاعر الإيجابيّة والأفكار الـمؤثّرة، ويحتوي على قيم أخلاقيّة فاضلة وأنماط سلوكيّة يوميَّة ضروريّة لحياة أفضل. الحبّ يعني: العطاء والعفو والحماية والخدمة. الحماية برزت في قولها لأيّوب وكرّرته مرارًا: “لن أكون سبب دمار بيتك يا أيّوب” (ص 71). والعفو برز في عدّة مواقع ومنها “مسامحة” الجميع (ص 176). وهذه الجوانب من الضروريّ تعليمها للأطفال إذ يقول زياد لعبير: “سنعلّم الأطفال أنْ يرسموا قوس قزح يخترق الغيوم الـملبَّدة، وورودًا أجمل في كلّ ربيع”…”فمهما كثر الظلم والبطش ما زال في الكون قلوب بيضاء”(ص 176). ومكانة خاصّة، أبرزتها الكاتبة لكيفيّة التعامل مع الضرير، وبرز هذا في علاقة عبير مع زياد الضرير كأنّه تحقيقًا لقول الشاعر:
” ليس الكفيف الذي أمسى بلا بصرٍ، إنّي أرى من ذوي الأبصار عميانا ” إيليا أبو ماضي”.
تغريد حبيب
كاتبة وشاعرة وفنّانة تشكيليّة فلسطينيّة، وُلدت في قرية دير حنّا الجليليّة. درست الفنّ التشكيليّ في كلّيتي سخنين وأورانيم. صدر لها كتاب في القصص والخواطر بعنوان “كأسًا شربتُ” (2010) ورواية بعنوان “هل الحبّ خطيئة؟”(2012)، ومجموعة قصصية بعنوان “عذريّة بخمس قطع نقديّة” (2017) بالإضافة إلى قصّتين للأطفال. تعمل مدرّسة للفنون، وهي عضو الاتّحاد العامّ للكتّاب الفلسطينيّين الكرمل 48، وعضو في الهيئة الإداريّة لجمعيّة “إبداع” (رابطة الفنّانين التشكيليّين العرب).
الـمصادر
إبراهيم فتحي. (2010). معجم الـمصطلحات الأدبيّة. مكتبة نور. Noor-book.com/rhpu6a
حبيب، تغريد. (2021). القبلة السوداء. الآن ناشرون وموزّعون، عمّان.
حمد، محمّد. (2018). شعريّة البداية في النصّ القصصيّ، يوسف إدريس نموذجًا. مجمع القاسمي للغة العربيّة. أكاديميّة القاسميّ، باقة الغربيّة.
صدوق، عبد الغني. (2022). “القبلة السوداء”، من عمق الجراح يبرقُ الأمل. موقع الرأي 12.3.2022. https://alrai.com/article/10723706
طنّوس، نبيل. (2021). راشد حسين: ويسكنه الـمكان. الرعاة – رام الله، والجسور – عمان.
طنّوس، نبيل. (2024). رواية “الخرُّوبة” لرشيد النجّاب بين توثيق الـمكان والتاريخ واقعًا وتَخَيُّلًا. جريدة الاتّحاد، الـملحق الأدبيّ، وموقع الاتّحاد. 15.11.2024. حيفا.
عساقله، عصام وخديجة مرعي. (2024). بناء الشّخصيّات في روايات أيمن العتوم. دار يزن للنشر والتوزيع، دالية الكرمل.
كامل، رياض. (2022). الـمتخيّل السرديّ العربيّ الحديث. الأهليّة للنشر والتوزيع، عمّان.
مجدي وهبة وكامل الـمهندس. (1984). معجم الـمصطلحات العربيّة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت.
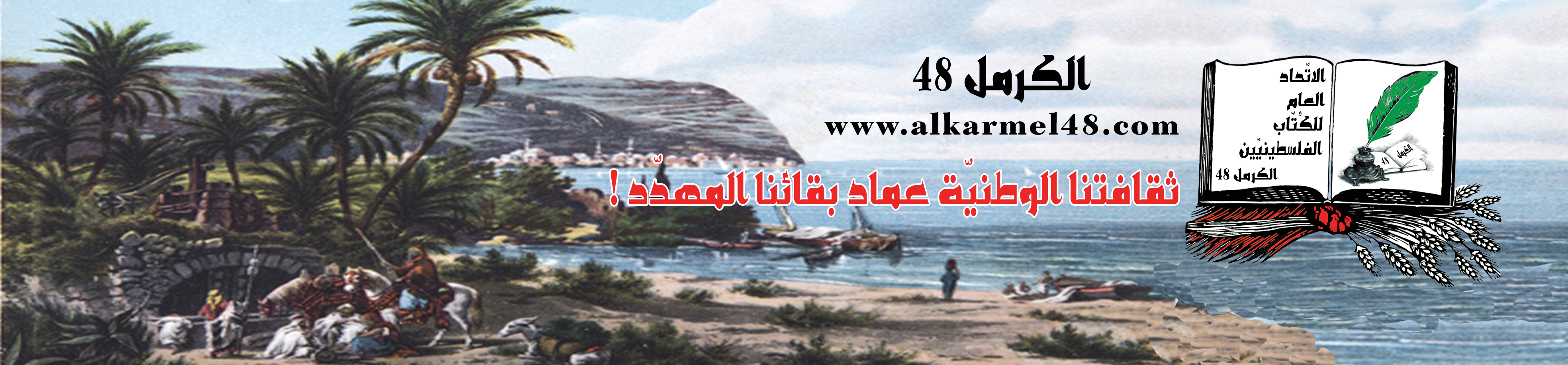 Alkarmel 48 الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48
Alkarmel 48 الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين – الكرمل 48